مقدمة:
يعتبر الجمال وسيلة ترسخ بها القيمُ وتثبتُ بأشكالٍ و مستوياتٍ عاليةٍ وجلية، وبقدر تسامي الإحساس بالجمال لدى الإنسان، والوعي بأبعاده الحسية والمعنوية، وتفاعله معه، تسمو روحه، وتتهذب أخلاقه، ويحسن سلوكه، وذلك كله – بدون شك – يشكل دورا هاما في رفع قدرات الفرد والمجتمع.
إن عدم إدراك كثير من الناس -اليوم- لحقيقة الجمال، وتباين نظرتهم واختلافها في ما يرتبط بكثير من أبعاده وتجلياته، إلى جانب ضعف إقبالهم عليه – رغم مركزيته وأهميته- تسبب في كثير من الأحيان -بوعي أو بدون وعي- في تراجع خطير لثقافة الجمال في الواقع، وظهرت نتيجة لذلك مظاهر عدة يجمعها القبح، والتسيب، والإهمال، و التشدد، والانغلاق، و أخلى كل ذلك الطريق أمام تعطيل النفَس التنموي في المجتمعات.
ولقد صار من المتعين في وقتنا الحاضر، أكثر من أي وقت مضى، تعميق النظر في مباحث الجمال استثمارا لأدواره الهامة في تحقيق التنمية واجبا، لذلك فإن هذه الورقة تروم معالجة الإشكال المرتبط بالسؤال عن سبل استثمار الجمال في تحقيق التنمية، و بيان الأدوار التي يضطلع بها – من خلال مجموع الأشكال الفنية التي يكتنزها- في نهضة الفرد والمجتمع.
ولتحقيق هذا الغرض تسعى هذه المحاولة إلى معالجة الموضوع من خلال دراسة مفاهيم الجمال والتنمية وأبعادهما، وأدوار الجمال الفني في تنمية المجتمع.
أولا: الجمال وأبعاده في التصورين الإسلامي والغربي:
يظهر أن مفهوم الجمال في اللغة متأرجح ما بين الصفات الحسية و المعنوية[1]، ولا يبعد معناه في الاصطلاح كثيرا عن معناه في اللغة، بل ينطلق منه ويؤسس عليه، وللقرطبي كلام جامع في الجامع، أورد فيه أغلب التعاريف الاصطلاحية لهذا المفهوم، جاء فيه: “الجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال. فأما جمال الخِلقة فهو أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائما، فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك… وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة والعدل والعفة، وكظم الغيظ، وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب المنافع فيهم وصرف الشر عنهم“[2].
إن المتتبع لمفهوم الجمال في الاصطلاح العام يلاحظ أن أغلب ما ذكر فيه لا يحُده، ولربما يرجع السبب إلى كونه متعلّقا بأحاسيسنا، وذواتنا، وبتذوّقنا له، لأنّ “الجمال شعور، والّذي يشعر بهذا الجمال هو الإنسان، وهي صفة طبيعيّة فيه، فهو يفهم الجمال بواسطة مشاعره“[3] لهذا نرى من المفيد أن نضع تعريفا إجرائيا نستطيع أن ننطلق منه في هذه الورقة، وهو أن الجمال يقصد به: الكمال في الأوصاف والحسن الكثير، ويقع على الأشكال والمضامين، ويترك في النفس البشرية تعلقا به.
إذا سلمنا بما ذكر فنستطيع أن نقول إن ألفاظ القرآن الكريم التي اختارها الله عز وجل للتعبير عن مفهوم الجمال كثيرة، فمن ذلك: الجمال، والحسن، والبهجة، والنضرة، والزينة، وقد أشار القرآن الكريم كذلك إلى بعض وسائل التجميل؛ كالحلية، والريش، والزخرف… واستعمل ألفاظًا أخرى للتعبير عن آثار الجمال كالسرور والعجب ولذة الأعين[4].
الجمال بهذا الاعتبار القرآني إذا, مفهوم ذو امتداد كلي شمولي، يمتد ليشمل علاقة الإنسان بالله وبالناس.
والجمال في السنة النبوية بالنظر إلى أحاديث كثيرة تتناوله[5]، يتضمن مواقف منسجمة مع تلك التي وردت في القرآن الكريم بشكل أو بآخر، فنتائج دراسة هذه الأحاديث تظهر أن المواقف والسلوكات الجمالية المعبر عنها هي أعمال عبادية تجلي رؤية الإسلام المعرفية للجمال؛ أعمال يتماهى فيها الظاهر بالباطن، والمادي بالمعنوي، وتجلياتها ذات بعد جمالي واضح، سواء في الشكل والمضمون، أو في المبنى والمعنى، أو في الرسم والوجدان.
نستطيع أن نؤكد – بعد هذا- أن ” (الجمالية) في الدين، لا تدرك من ألفاظ بعينها في الشرع فحسب، بل هي (مفهوم) مبثوث في أصول الدين وفروعه، إنها تؤخذ من كل معاني الخير، والتخلق، والتجمل، والتزين، والإحسان، ونحو هذا من معاني الجمال، المبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية، مما من شأنه أن ينتج شعورا بالجمال عند ممارسة الدين، ولدى الانخراط في الإبداع تحت ظلاله الوارفة!“[6] فكأن تجمل الفرد ظاهرا وباطنا في الإسلام منهج حياة!
ولاشك أن المتتبع للتراث الإسلامي سيقف مذهولا أمام الحجم الكبير لحضور الجمال بهذا المعنى المتقدم عند العلماء المسلمين وبنفس التوهج الذي تقدم في القرآن والسنة.
لقد تعامل العلماء المسلمون على مر الأزمان مع موضوع الجمال تعاملا وظيفيا واعتبروه موصلا إلى الله وسبيلا لعبادته، ولقد جسدوا ذلك قولا وعملا، فكانت قيمة الجمال عندهم موضع عناية عز نظيرها، وبحكم هذه الثقافة الجمالية السائدة في المجتمع، اكتسب الإنسان في ظلها فلسفة تطبع سائر أحواله، منطلقها ومنشؤها الدين.[7]
في الجهة المقابلة لهذا “التصور الإسلامي” للجمال، نجد أن “التصور الغربي” له يتطلب منا بدأ البحث من العصور اليونانية القديمة، أي منذ نشأة المفهوم في الغرب.
إن الدراسات المنجزة في هذا الصدد تفيد أن المفكرين والفلاسفة الغربيين منذ العهد اليوناني القديم اضطربوا في تحديد معنى (الجمال) ومقاييسه في الشيء الجميل، واختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً.
ولبيان هذا الأمر ننطلق من أفلاطون، لأن فكرة الجمال لم تعرف إلا بعد أن عرفها هو، وهو أول من تكلم عنها وأول من وضع نظرية في علم الجمال عند اليونان[8].
يرى أفلاطون أن الجمال في الأشياء مجرد انعكاس للجمال الحقيقي الكامل والمطلق الّذي يسمو عليها، هذه الأشياء الجميلة التي نراها في عالمنا المحسوس كالوردة أو المرأة أو غيرهما، إنما هي فقط – حسب تصوره – تعطينا مثالا للجمال من خلالها[9]، والمطلوب هو أن نرتقي من تأمّل الأشياء الجميلة، إلى تأمّل النّفوس الجميلة، وإلى الأفعال الجميلة، حتى نصل إلى الجمال المطلق الذي يرتبط بالفضيلة، وبالتّالي بالخير الّذي يُعدُّه مثال المُثُل.. ولذلك يقول: “إن الخير لا يمكنه أن يكون جميلاً، و لا الجميل خيّراً، إن لم يكن الاثنان متطابقين أحدهما مع الآخر“[10].
بالنسبة لتصور الفلسفة الأوروبية الحديثة للجمال فهو مختلف عما سبق، فها هو كانط على سبيل المثال وهو أحد الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية الحديثة، ومن أبرز الفلاسفة – كما يعتبره كثيرون- الذين اهتموا بالجمال، و قد ألف في ذلك كتابا يشكل دعامة قوية في بناء علم الجمال أسماه “نقد مَلَكَة الحُكم”، يرى فيه أن “الجميل هو تمثل ملكة الحكم لموضوع ما يثير لذة من دون الحاجة إلى مصلحة، فمن طبيعة الجميل أن يوفر اللذة دون أن يحقق غاية أخرى سوى هذه اللذة نفسها“[11]، ولذلك لا يرتبط الحكم الجمالي لديه بالمنفعة المادية[12].
والدارس لهذه النظرية الجمالية “الكانطية” يخلص إلى أن كانط انتقل زمانيا بالجمال من مرحلة الميتافيزيقا التي كان البحثُ فيها عن الجمال الفني والطبيعي، إلى المرحلة النقدية؛ حيث صار البحث فيها عن شيء آخر هو إمكانية إدراك وحُكم الإنسان على الجميل، أي استطاع أن يرسم فلسفة للجمال يمكن تلمسها في الواقع، لا في عالم المثل!
وإذا انتقلنا عبر الزمن إلى العصر الحديث لنبحث في تصور الفلسفة الوجودية الحديثة – مثلا – للجمال، من خلال رائد من روادها وهو جان بول سارتر – وهو أحد أكثر الفلاسفة تأثيراً في أوساط واسعة في العالم كله، وبخاصة الغرب- فسنجده قد شدد على مقولة الحرية، فاعتبرها أصل الوجود الإنساني، بل هي قدره الوجودي، وصولاً إلى قوله: “إننا لا ننفصل عن الأشياء سوى بالحرية“[13]، والحديث عن الجمال عند سارتر ينطلق من هذا التصور، فهو يرى أن التجربة الجمالية بوصفها تجربة إنسانية ناتجة عن نشاط إنساني إبداعي، يعبر من خلاله الفرد عن حريته، هذا الإبداع الذي يجد له مساحة واسعة في الخيال كما يبين ذلك مؤلف كتاب” الوجود وعلاقته بالفن عند جان بول سارتر” بقوله: “الموضوع الجمالي عند سارتر موضوع متخيل، فهو لا يوجد ولا يمكن التعامل معه إلا على أساس من فعل الوعي التخيلي، كما أنه يظهر في اللحظة التي عندها يكابد الوعي تغيرا جذريا حيث ينتفي فيه العالم ويصير متخيلا، أي أن الموضوع الجمالي هو موضوع متخيل لا واقعي، فالوعي التخيلي يقوم بتركيب الموضوع الجمالي وفهمه عندما ينقله من الواقعي ويرفعه إلى اللاواقعي“[14].
يظهر من خلال البحث في هذه الرؤية أن جول بول سارتر قد ذهب بعيدا في تصوره للجمال بربطه بالحرية وهذا ما دفع بصالح بن أحمد الشامي في كتابه “فلسفات بغير جمال.. الوجودية والجمال” إلى انتقاد رؤية الوجوديين (عامة) ورؤية جان بول سارتر (خاصة) للجمال بقوله: “إن معطيات الوجودية كلها مناقضة للقيم الجمالية، ولذلك فإن الوجوديين حينما يتحدثون عن الفن يقيمون أحكامهم على ما يفرضه مذهبهم لا على ما يفرضه واقع الفن نفسه“[15].
بعد هذا العرض الذي شمل كلا من التصورين الإسلامي والغربي للجمال؛ نستطيع أن نخلص إلى نتائج يمكن جمعها في الآتي:
- مفهوم الجمال في اللغة وفي الاصطلاح الإسلامي متأرجح ما بين الصفات الحسية والمعنوية، والتعريفات العديدة للجمال تكاد تجمع أن جمال الشيء هو كماله مما يبعث في النفس السرور والبهجة، وهذا ما أكده القرآن الكريم ، حيث عبر عنه بمرادفات عدة ذكرنا بعضها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في التجمل والحث عليه بأقواله وأفعاله وتقريراته، و ذلك ما أخذ به العلماء المسلمون، حيث تعاملوا مع موضوع الجمال تعاملا وظيفيا، واعتبروه موصلا إلى الله وسبيلا لعبادته، ولقد جسدوا ذلك قولا وعملا، فكانت قيمة الجمال عندهم موضع عناية عز نظيرها.
- مفهوم الجمال عند العلماء المسلمين أوسع وأعمق من مفهومه عند فلاسفة الغرب، وكل عالم وفيلسوف لا يمكن دراسة رؤيته الفكرية بمعزل عن واقعه و فلسفته، وهذا ما وجدناه مثلا عند أفلاطون الذي تأثرت فلسفته ونمت وازدهرت في عصر انحدار الحضارة التي عاصرها، فلا عجب إن رددت فلسفته صدى هذا الانحلال فجاءت أميل إلى الانحراف عن الواقع المحسوس وزهدا فيه، وأشد تعلقا بعالم آخر توجد فيه أحلامه، ونفس الشيء يتعلق بسارتر الذي جاءت آراؤه الجمالية مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤيته الفلسفية والعقدية والاجتماعية.
ثانيا: التنمية وأبعادها في التصورين الإسلامي والغربي:
لاشك عند كل باحث متتبع أن “مفهوم التنمية أصبح عنواناً للكثير من السياسات والخطط والأعمال، على مختلف الأصعدة، كما أصبح هذا المصطلح مثقلاً بالكثير من المعاني والتعميمات، وإنْ كان يقتصر في غالب الأحيان على الجانب الاقتصادي، ويرتبط إلى حدّ بعيد بالعمل على زيادة الإنتاج الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستهلاك، لدرجة أصبحت معها حضارات الأمم تقاس بمستوى دخل الفرد، ومدى استهلاكه السنوي للمواد الغذائية والسكنية بعيداً عن تنمية خصائصه ومزاياه وإسهاماته الإنسانيّة، وإعداده لأداء الدور المنوط به في الحياة، وتحقيق الأهداف التي خلق من أجلها”[16]، لذلك سنحاول في هذا المطلب الإجابة عن سؤال مركزي هو: ما التنمية في التصورين الإسلامي والغربي وما أبعادها؟
جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس قوله: “النون والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادة”[17]، يقال: “نما ينمو نموا بمعنى: زاد”[18]. و”نما الخضاب: ازداد حمرة وسوادا”[19]، و”نمى النار: رفع وأشبع وقودها”[20]، و”من نفس المعنى – أي معنى الكثرة والزيادة – نما الزرع، ونما الولد، ونما المال”[21] و”تنمى الشيء: ارتفع من مكان إلى مكان”[22]…
وإذا كان لفظ النمو في معناه اللغوي العام يرجع إلى معنى الارتفاع والكثرة والزيادة، فقد ذكر له الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات معنى يفهم منه أن كل زيادة غير طبيعية لا يطلق عليها لفظ تنمية أو نمو، يقول: “النمو: هو ازدياد حجم الجسم، بما ينضم إليه ويداخله في جميع الأقطار نسبة طبيعية بخلاف السمن والورم، أما السمن فإنه ليس في جميع الأقطار، إذ لا يزداد به الطول، وأما الورم فليس على نسبة طبيعية”[23].
بعد التعرف على مفهوم التنمية من حيث اللغة والاصطلاح نقول أن مفهوم التنمية في الإسلام إن كان غير موجود بلفظه، فهو موجود بألفاظ عديدة مترادفة، وهي في كثير من النصوص القرآنية والحديثية تأتي بصيغة “التعمير” و”العمارة” و”الحياة الطيبة” و “التثمير” وغيرها، وهي كلها ألفاظ محملة بمعاني التنمية، وفي ذلك قال الله عز وجل :﴿هو الذي أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ (هود:61) أي “استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض، تبنون، وتغرسون، وتزرعون، وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها، وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك، فلا تشركوا به في عبادته”( تفسير البغوي) وقال الله سبحانه أيضا :﴿من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة﴾ (النحل :97) وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الحياة الطيبة “الرزق الحسن في الدنيا” (تفسير الطبري)،فالمستفاد من هذه النصوص أن مفهوم التنمية في “التصور الإسلامي” لا يخرج عن الغاية من خلق الإنسان ووجوده على الأرض، والتي هي إخلاص العبادة لله ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾ (البينة: من الآية5)، تلك الغاية التي تواترت النصوص الشرعية في تحديدها وبيانها[24]، وهي نصوص كثيرة تفيد أن الإنسان لم يخلق عبثا، بل خلق لعبادة الله، و إذا كانت العبادة تمثل الغاية والقصد الأساس للتنمية في “التصور الإسلامي” فهي تحتاج إلى جانب ضبطها بضابط العبادة ضابطا أخر يجعلها تنمية إسلامية بحق، ونقصد هنا امتثالها للصواب أي:” أن يستجيب النموذج التنموي بكل جوانبه ومراحله وتفاصيله لتوجيهات الشريعة الاسلامية، ومقاصدها الكلية والجزئية، ولأحكام الحلال والحرام، ولقيم: الحق، والعدل، والمساواة والإحسان والتعاون على الخير...”[25] ولأجل ذلك كله تحتاج التنمية في التصور الإسلامي لأن تكون مرنة ومنفتحة وقابلة للاقتباس والاستفادة من الغير مع الحذر من الانزلاق والسقوط في فلكه وفلسفته.
بالنسبة للتصور الغربي لمفهوم التنمية فهو يختلف عن سابقه من حيث المنطلقات والنتائج وهذا ما سنبينه.
يذكر ناصر عارف أن مفهوم التنمية Development برز بصورة أساسية في الغرب “منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يُستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره (..) إلا على سبيل الاستثناء، فالمصطلحان اللذان استُخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كانا التقدم الماديMaterial Progress، أو التقدم الاقتصاديEconomicProgress”[26].
ويظهر أن التعريف الوارد في “تقرير التنمية البشرية” الصادر عن “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة” حيث التنمية البشرية فيه يقصد بها:” عملية توسيع خيارات الناس”[27]، أعم وأشمل، لأن خيارات الناس ليست دائما محدودة، ويمكن أن تتغير بمرور الوقت، ولو أن الخيارات الأساسية الثلاثة على جميع مستويات التنمية البشرية حسب عدلي أبو طحون في كتابه “إدارة وتنمية الموارد البشرية” هي: أن يعيش الناس حياة مادية صحية، ويكتسبوا المعرفة، ويحصلوا على موارد لازمة لمستوى معيشة لائق”[28]، فالتنمية إذا بهذا المعنى تحكمها إلى جانب المؤشرات الاقتصادية مؤشرات أخرى صحية، معرفية، وأيضا سياسية وحقوقية واجتماعية وبشرية..وكل هذه المؤشرات “تبقى هي جوهر التنمية بالمفهوم الغربي في حين تبقى أنواع التنمية الأخرى في حكم الوسائل والشروط التي تتطلبها، أو في حكم النتائج والآثار المترتبة عنها“،[29] ومما سبق نستفيد أن العملية التنموية القائمة على هذه المؤشرات المذكورة تلتقي في نهاية المطاف في غاية واحدة هي “الوصول إلى أكبر قدر من الرفاه المادي، وتحقيق أفضل ظروف المتعة والراحة والثراء، وتطوير وتنويع أشكال المتعة واللذة … ولعل هذا ما حول عملية الإنتاج والاستهلاك- في الغرب- إلى نوع من الهستيريا والجنون الناجم عن الجري المستمر والسعي الدؤوب وراء شيء غير معروف“[30].
يذكر عبد الكبير حميدي في كتابه” الإسلام والمسألة التنموية” أن تأثر مفهوم التنمية في التصور الغربي بمفهوم الحرية التي تعني عنده “حق الفرد في ممارسة الحياة والتمتع بها دون قيد أو سلطة أو رقابة من أحد” كان له بالغ الأثر على مفهوم التنمية حيث أخضعه لكثير من الشعارات والمقولات الخالية من أي نفس إنساني، والفارغة من أي مضمون أخلاقي، أو إنساني، أو ديني.. ونتيجة لذلك تحولت العملية التنموية برمتها إلى ورش متقلب ومتحرك باستمرار ومفتوح على كل الاحتمالات، لأن ما يتحكم فيها هو رغبات ونفوذ الأفراد والمؤسسات. وبذلك أصبحت التنمية في الغرب عملية بدون مرجعية ثابتة، وبلا ضوابط منظمة وموجهة. وقد نجم عن افتقار التنمية عند الغرب لأي مرجعية أخلاقية، ولأي ضوابط أو قيم، وخلوها من أي بعد إنساني نتائج كارثية، منها: الكلفة الإنسانية والاجتماعية الباهضة، تزايد الحروب والنزاعات والأزمات الدولية، تدمير البيئة الطبيعية.[31]
وبعد أن عرض حميدي لهذه الآفات يذكر أنه رغم كل هذا لابد من الإقرار لهذا النموذج التنموي الغربي بكثير من الحسنات ونقاط القوة، ذكر منها:
– شمول وتكامل وجدلية العملية التنموية عنده، فالسياسي فيها يؤثر في البشري، والبشري يؤثر في الاقتصادي والاجتماعي، وهذا الأخير يؤثر في الأول، وهكذا.
– تقدم هائل في المجالات الصناعية والتكنولوجيا والبحث العلمي.
– توفير بيئة مناسبة قوامها الحرية في التفكير والمشاركة والتعبير، وشعور المواطن بكرامته وتمتعه بحقوقه، وهي كلها شروط أساسية لتجنب انعكاساتها السلبية على مختلف جوانب الحياة العامة، والتي يمكن أن تطبعها بطابع التسيب والتخلف والفوضى”.[32]
نستطيع أن نخلص من خلال ما سبق إلى أن التنمية بمفهومها الغربي وإن كانت تختلف من حيث منطلقاتها ونتائجها مع التنمية بالمفهوم الإسلامي إلا أنها حققت نتائج لا تخلوا من إيجابيات عديدة يستفاد منها. ما علاقة المفهوم بالنتائج؟؟؟؟
ثالثا: أدوار الجمال الفني في تنمية المجتمع
إن دعوة الإسلام للإنسان إلى الحرص على الجمال – سواء في مظهره[33]، أو في مطعمه[34]، أو في سلوكه[35]، أو في محيطه من خلال حثه على الحفاظ على البيئة؛ بأن أمره بالاقتصاد في ماء الوضوء، وعدم تلويث المياه، والدعوة إلى غرس الأشجار، والاعتناء بالحيوان، و إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك- فيها ما يفيد أن للجمال سلطانا يحكم به الأفراد والمجتمعات، فتنمية الذوق الجمالي بشكل عام، والحس الجمالي الفني بشكل خاص، قادران على النهوض بالمجتمع، وعلى جعل الأفراد المشكلين له يمتلؤون بحب الجمال، فيسعى الفرد فيهم لأن يكون جميل الجسد والروح، متناسق المظهر والمخبر، كريم القلب والقالب.
فما هي أدوار الجمال الفني في تنمية المجتمع يا ترى؟
قبل الحديث عن أدوار الجمال الفني في تنمية المجتمع سنتحدث بداية على أدوار الجمال الفني في تنمية الفرد.
يزخر القرآن الكريم بالعديد من القصص التي تبين أثر الجمال على النفس، ففي سورة النمل مثلا يحدثنا الله تعالى عن قصة إيمان بلقيس ملكة سبأ التي ﴿أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم﴾ (النمل، من الآية: 23)، فحينما دعيت لمقابلة نبي الله سليمان ووجدت نفسها أمام جمال القصر العظيم المبني من زجاج فوق الماء الجاري دهشت وبلغ بها أثر دهشتها من جمال ما رأت- وهي صاحبة العرش العظيم- أن أعلنت إسلامها ﴿أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (النمل: من الآية 40). لقد أخذ المشهد بمجامع لبّها واستحوذ على تفكيرها حتى بلغ المدى من نفسها.. فما كان أمامها إلا أن أعلنت إسلامها.
يعلق منير الجوري على هذه القصة قائلا: “هكذا يأتي إسلامها أثرا مباشرا لإدراك جمالي ﴿فلما رأته حسبته لجة﴾ ثم انفعال جمالي ﴿رب إني ظلمت نفسي﴾ ثم اندماج جمالي ﴿أسلمت مع سليمان لله رب العالمين﴾ إنه دليل قاطع على سلطان الجمال على النفوس“[36].
وإذا كانت المؤثرات في المشهد أعلاه مؤثرات جمالية مادية، تنبع من فن الهندسة وجمال التصميم، فإن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ما يجعلنا نقف على تأثير الجمال الإنساني في صورته الظاهرة على النفس.
وليست القصة بكاملها هي محور حديثنا هنا، وإنما يعنينا منها حديث القرآن عن أثر الجمال في شكله الإنساني الظاهر على نفس امرأة العزيز التي شغفها يوسف حبًا، وكذلك على نفوس صويحباتها.
إن امرأة العزيز ما كانت ليملأ عليها يوسف قلبها وعقلها إلا لجمال خُلقه وخِلقته، فهي نتيجة لاختلاطها الدائم به، عرفته وعرفت فضائله و حسن تصرفه، وبذلك تجلى لها حسنه وجماله ظاهرًا وباطنا، ومع أن النسوة صويحباتها لم يبلغ بهن حب يوسف هذا الحد فقد تحدث القرآن عن تأثرهن فقال: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾.
أكبرنه.. وقطعن أيديهن! أي جرحنها، لقد شغلهن حسن وجمال طلعة يوسف عن أنفسهن وما في أيديهن، فكان هذا التأثير الكبير الذي أفقدهن التحكم في أنفسهن!
إذا كانت هذه هي آثار الجمال وأدواره على النفس فما أدواره يا ترى على المجتمع؟
تحدث مالك ابن نبي -في نهاية القرن الماضي- عن الجمال، فبين أنه يشكل وجهَ الوطن في العالم، مما يتطلب حفظ الوجه لحفظ الكرامة، ولفرض الاحترام على الجيران الذين ينبغي أن يدان لهم بنفس الاحترام، فبالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد يجد الإنسان في نفسه نزوعا إلى الإحسان في العمل وتوخيا للكريم من العادات. والجمال في فكر ابن نبي ليس قضية ذات أهمية على المستوى الفردي فحسب، بل للجمالِ أهمية اجتماعية قصوى إذا ما اعتُبر المنبعَ الذي تنبُع منهُ الأفكارُ وتصدرُ عنهُ بواسطةِ تلكَ الأفكارِ أعمالُ الفردِ في المجتمع. وترجع هذه الأهمية إلى التأثيرِ العامِّ لهذا العُنصر الذي يمُس كلَّ دقيقة من دقائق الحياة، كذوقنا في الموسيقى وفي الملابس والعادات وأساليب الضحك والعطاس، وكطريقة تنظيم بيوتنا، وتمشيط أولادنا، ومسح أحذيتنا وتنظيف أرجلنا.
وعليه، فالجمال هو الإطار الذي تتكون فيه أي حضارةٍ، فينبغي أن ننتبه إلى ذلك في نفوسنا، وأن نتمثل في شوارعنا ومقاهينا مسحة الجمالِ نفسها[37].
تتجدد اليوم هذه الدعوة من فلاسفة ومفكرين من العالم الإسلامي، فيقول طه عبد الرحمان وهو واحد منهم: “إذا تعذر على أمة ما الإسهام في محيطها الحضاري ببعدها الجلالي الذي هو القوة والبأس فإنه يبقى لها دائما متسع في أن تسهم في هذا المحيط ببعدها الجمالي الذي هو الرقة واللطف“[38].
ومن هنا يذهب طه عبد الرحمن إلى أنه يتعين على مفكرينا أن يفكروا مليا في الطرق الجمالية التي ينبغي أن تسهم بها الأمة الإسلامية العربية في “القرن” الذي أهل علينا، بقول: “متيقن أنه لو أننا نهتدي إلى هذه الطرق فسوف يكون لنا من العطاء الجمالي ما نجعل أهل هذا القرن يحتاجون إلينا قدر احتياجنا إلى عطائهم الجلالي“[39].
إن من أبرز عوامل التنمية المجتمعية توجيه البوصلة نحو الجمال، وإنه لمن المنطقي توظيف الجمال في أصغر تجلياته في السعي نحو التنمية الكبرى للمجتمع، فانظر كيف ربط مالك بن نبي بين الجمال في واحدة من أصغر تجلياته وهي المرتبطة بلباس الفرد مثلا، أو بالحقيبة نفسها التي يضع فيها هذا اللباس، وبين مصيره ومصير المجتمع الذي يوجد فيه، فكأنه يؤكد أن عنصر الجمال ليس شيئا يمكن إهماله، ولكن لأهميته ينبغي الالتفات إليه وإعطاؤه ما يستحقه، يقول: “والواقع أن أزهد الأعمال- في نظرنا- له صلة كبرى بالجمال، فالشيء الواحد قد يختلف تأثيره في المجتمع باختلاف صورته التي تنطق بالجمال، أو تنضح بالقبح، ونحن نرى أثر تلك الصورة في تفكير الإنسان، وفي عمله، وفي السياسة التي يرسمها لنفسه، بل حتى في الحقيبة التي يحمل فيها ملابس سفره.
ولعل من الواضح لكل إنسان أننا أصبحنا اليوم نفقد ذوق الجمال، ولو أنه كان موجودا في ثقافتنا، إذن لسخرناه لحل مشكلات جزئية، تكوِّن في مجموعها جانبا من حياة الإنسان.
ويكفينا للتدليل على ذلك ما نراه مثلاً من شأن ذلك الطفل الذي يلبس الأسمال البالية، والثياب القذرة، التي إن شئنا وَصْفها لقلنا إنها ثياب حيكت من قاذورات وجراثيم، مثل هذا الطفل الذي يعيش جسمه وسط هذه القاذورات والمُرقَّعات غير المتناسبة، يحمل في المجتمع صورة القبح والتعاسة معا، بينما هو جزء من ملايين السواعد والعقول التي تحرك التاريخ، ولكنه لا يحرك شيئاً، لأن نفسه قد دفنت في أوساخه، ولن تكفينا عشرات من الخطب السياسية لتغيير ما به من القبح، وما يسوده من الضعة النفسية، والبؤس الشنيع.
فإن هذا الطفل لا يعبر عن فقرنا المُسلَّم به، بل عن تفريطنا في حياتنا.. فليست هذه الأسمال جراباً للوسخ فقط، ولكنها سجن لنفس الطفل أيضاً“[40].
ثم يختم مالك بن نبي كلامه – بربط التنمية في جميع تجلياتها بالجمال – بقوله: إن “الإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق الجمال، بل إن الجمال هو الإطار الذي تتكون فيه أية حضارة، فينبغي أن نلاحظه في نفوسنا، وأن نتمثل في شوارعنا، وبيوتنا، ومقاهينا، مسحة الجمال نفسها التي يرسمها مخرج رواية في منظر سينمائي أو مسرحي، يجب أن يثيرنا أقل نشاز في الأصوات، والروائح، والألوان، كما يثيرنا منظر مسرحي سيء الأداء.
إن الجمال هو وجه الوطن في العالم، فلنحفظ وجهنا، لكي نحفظ كرامتنا، ونفرض احترامنا على جيراننا، الذين ندين لهم بنفس الاحترام “[41].
خاتمة:
خلاصة لما سبق نقول إن التنمية لا تنفصل عن الجمال، وأن المجتمع الذي ينطوي على غير صور الجمال بمختلف أشكاله لابد أن يظهر أثر هذه الصور في أفكاره، وأعماله ومساعيه، ذلك أنه “بالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد الإنسان في نفسه نزوعا إلى الإحسان في العمل، وتوخيا للكريم من العادات.
فالجمال إذا بما له من قدرة على التأثير في الأفكار التي تصدر عنها أعمال الفرد في المجتمع قادر على تحقيق التنمية المجتمعية.
[1]– الراغب الأصفهاني يرى: “الجمال الحسن الكثير“، وابن فارس يراه في “عظم الخلق“، وابن منظور يقرنه ب”البهاء والحسن“.. (انظر: الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم – الدار الشامية، 2009، ص1/202، وأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار الجيل، د ت، ص1/481، وابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1997، ص11/126)
[2]– أبو عبد الله شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384ه، ص9/70-71.
[3]– فريدريش شيللر، في التربية الجمالية للإنسان، ترجمة: وفاء محمد إبراهيم، الهيئة المصرية للكتاب، 1995، ص39.
[4]– مفردة “الجمال” وما تدور عليه جاءت ثمان مرات في القرآن الكريم على صيغ مختلفة، وقد تتبع الدكتور رمضان خميس زكي الغريب في بحثه الموسوم بمنهج القرآن في غرس القيم الإسلامية ورود هذه الصيغ في كتاب الله، واستنبط منها دلالات نذكر من أهمها أن ورود لفظ “الجمال” في المرحلة المكية خمس مرات، بينما في المرحلة المدنية ثلاث مرات يفيد مدى ارتباطه بالأمور التصورية والعقدية الكبرى التي يقوم عليها الإسلام، وهذا المعنى مهم و يقود لأمر آخر قد تخلص له الدراسة فيما بعد وهو: أن الجمال ليس دائما شيئا تحسينيا، بل قد يكون أساسا وضروريا في بناء الإنسان.
[5]– أورد محمد أحمد عبد الغفور في بحث له معنون ب ” الجمال في السنة النبوية: دراسة موضوعية أربعةً منها شرحها شرحا مبينا لمضامين الجمال فيها.
[6]-فريد الأنصاري، جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح، منشورات ألوان مغربية، ط 1، 2006، ص 6.
[7]– محمد الطاهري، الجمال عند فريد الأنصاري من خلال إنتاجاته الأدبية، ورقة علمية ألقيت في الملتقى الثالث لخريجي ماستر التربية والدراسات الإسلامية، الرباط، في 15 و16 و17 يولويز 2019.
[8]– ركماوي عبد الله، الوعي الجمالي في الخطاب الفلسفي.. هيجل نموذجا.. مشروع فلسفة الثقافة والجمال، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في الفلسفة، جامعة وهران كلية العلوم الاجتماعية قسم الفلسفة، ص 31.
[9]– عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط3، 1986، ص 37.
[10]– نفسه، ص 239.
[11]– محمد نبيل، في سؤال الجماليات، https://www.hespress.com/writers/241435.html
[12]– زهير الخويلدي، مفهوم الجميل بين المعطى الطبيعي والبعد الفني،
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=3884
[13]– عبد الله العروي، مفهوم الحرية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط5، 1993، ص 68.
[14]– عباس غنية وخميس زهرة العلاء، الوجود وعلاقته بالفن عند جان بول سارتر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر الأكاديمي في الفلسفة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، د ت، ص 43.
[15]– صالح بن أحمد الشامي، فلسفات بغير جمال.. الوجودية والجمال،
http://www.alukah.net/culture/0/54049/#_ftn19
[16]– إبراهيم العسل، التنمية في الإسلام: مفاهيم، مناهج وتطبيقات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، د.ط، 1996، ص 13 .
[17]– ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ـتحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط1، 1991، م5، ص 479.
[18]– الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط2، 2000 ، ص 1756.
[19]– نفسه، ص 1756.
[20]– نفسه، ص 1756.
[21]– إبراهيم أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط، ط2، د.ت ، ج1، ص 956.
[22]– ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ـتحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط1، 1991، م5، ص 479.
[23]– الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، د.ط، 1990، ص 297.
[24]– من هذه النصوص قول الله عز وجل: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (الذاريات:56)، وقوله سبحانه: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ (البقرة: من الآية30) وقوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون﴾ (المومنون:115)
[25]– عبد الكبير حميدي، الإسلام والمسألة التنموية تأصيلا وتنزيلا.. نحو صياغة نظرية إسلامية في التنمية، طوب بريس، الرباط، ط1، 2006، ص 11.
[26]– ناصر عارف، مفهوم التنمية:
https://www.scribd.com/document/7909795/
[27]– عبد القادر محمد عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، الإسكندرية، د ط، 1999، ص19.
[28]– عدلي أبو طحون، إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، د ط، 1998، ص23.
[29]– عبد الكبير حميدي، الإسلام والمسألة التنموية تأصيلا وتنزيلا.. نحو صياغة نظرية إسلامية في التنمية، طوب بريس، الرباط، ط1، 2006، ص 11.
[30]– نفسه، ص 11.
[31]– نفسه، ص 11 – 13.
[32]– نفسه، ص 15.
[33]– من ذلك قول الله عز وجل: “يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين”(الملك 5).
[34]– من ذلك قول الله عز وجل: ﴿قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده من الطيبات والرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة﴾ (الاعراف31).
[35]– من ذلك قول الله عز وجل :﴿وعباد الرحمان الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”﴾ (الفرقان63).
[36]– الإحساس بالجمال منهاج تربية، منير الجوري. مقال في موقع:www.aljamaa.net
[37]– إنسان الحضارة في فكر ابن نبي، مصطفى عشوي، بحث منشور على الشابكة(بتصرف)
http://faculty.kfupm.edu.sa/MGM/mustafai/Temp/Man%20in%20Ben%20Nabi%20Thought.doc
[38]– حوارات من أجل المستقبل، د.طه عبد الرحمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2011،ص:142.
[39]– نفسه،ص:142.
[40]– شروط النهضة، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، د.ط، 1986، ص 92.
[41]– نفسه، ص 94.


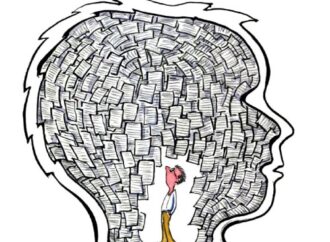

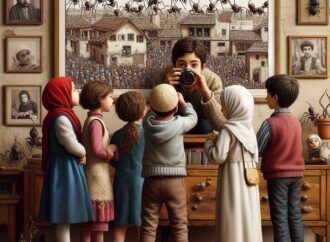
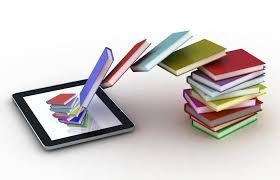
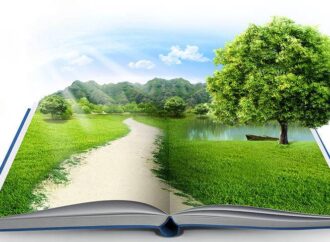






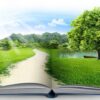

اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *