تقرير حول أطروحة دكتوراة تحت عنوان: “الرواية المغربية المعاصرة: التعدد اللغوي والبوليفونية”.
الباحث محمد الغمروسي: كلية اللغات والفنون، جامعة ابن طفيل القنيطرة
تحت إشراف: الدكتور : محمد هموش: كلية اللغات والفنون، جامعة ابن طفيل القنيطرة
يتخذ البحث الذي نهدف إلى إنجازه من “التعدد اللغوي والبوليفونية” موضوعا للاشتغال. وهو أمر يستدعي منا حسب فهمنا، الوقوف عند هذا المصطلح وقفة مطولة، من أجل تحديد مفهومه، والخروج بدلالته من الفوضى والاضطراب اللذين ميزا تداوله نقديا وابداعيا. فما وسم مصطلح “التعدد اللغوي”، هو ذلك الاضطراب الواضح في تحديد مفهومه، إذ إن كل كاتب وكل ناقد يعطيه ما شاء من حمولات دلالية قد تصل التناقض الصارخ. ولعل تغييب الشروط التاريخية والموضوعية الضابطة لقواعد الكتابه الروائية المعاصرة وأهدافها، قد كان له أكبر الأثر في ترك المفهوم مفتوحا على كل الاحتمالات الدلالية، مع ما ترتب عن ذلك من مظاهر الاضطراب وسوء الفهم.
كما شكل التركيز على استراتيجية الخرق والتجاوز، دون الالتفات إلى ربط مفهوم التعدد اللغوي بالنظام المؤسس له، القاسم المشترك بين أغلب من حاولوا مقاربة هذا المفهوم؛ بحيث لم يتم التنبه إلى ارتباطه بمجموع الإشكاليات الثقافية والتاريخية، التي لازمت نشأة الأجناس الأدبية الحديثة في حقل الثقافة العربية. ومن تم؛ فإن رهاننا كان هو محاولة إخضاع هذا المفهوم للمساءلة الأكاديمية المحض، بعيدا عن المواقف الذاتية وردود الفعل، سبيلنا إلى ذلك هو العمل على تأطيره معجميا واصطلاحيا عبر البحث في المعاجم العربية وكذا المعاجم الفرنسية، ثم تتبع مراحل ظهوره بالاستقصاء حول زمن ظهوره، ومحاولة رصد الكيفية التي تمثل بها المبدعون المغاربة “التعدد اللغوي والبوليفونية”، وإبراز آثاره على صعيد التحققات النصية.
يقودنا التفكير في الإطار العام للموضوع إلى بلورة رؤية معرفية ومنهجية نستطيع من خلالها رصد التعدد “اللغوي والبوليفونية” وآليات اشتغالهما في الرواية المغربية المعاصرة من خلال مجموعة من النماذج التطبيقية، بالإضافة إلى محاولة معرفة كيف تتفاعل الخطابات وتتحاور داخل المجموعة الروائية لتخلق البوليفونية و التعدد اللغوي، وهذا يساهم في إثارة مجموعة من القضايا الجزئية التي يتحدد عبرها- التعدد اللغوي والبوليفونية- ومن ذلك البحث في كيفية اشتغالهما وتحديد مستويات تحقق علاقة التفاعل بينهما، والبحث في مدى إسهام التعدد اللغوي في تشييد جمالية النص الروائي ودلالته. ويلاحظ أن هذه الاهتمامات تصب كلها في محاولة الكشف عما يقدمه التفاعل الحواري للرواية المغربية.
وانطلاقا من تصورنا لموضوع بحثنا،“الرواية المغربية المعاصرة: التعدد اللغوي والبوليفونية”، قصدنا من هذا العنوان الاشتغال بنماذج معينة، بغية إثارة مجموعة من القضايا بشكل محسوس، خصوصا مع الاختلاف البين في فهم الروائيين المغاربة لتعدد اللغات والأصوات الروائية وأشكال التعامل معها، الأمر الذي انعكس على التحققات النصية للرواية المراهنة على التعدد اللغوي. لكن بعد جمعنا لمادة البحث وتقدمنا في العمل لاحظنا بأن الاشتغال على هذا الموضوع والإحاطة به، يتطلب إضافة إلى الوقوف على نماذج تمثل تجليات التعدد اللغوي في الرواية المغربية، أن نقف على الإشكالات التي يطرحها موضوع بحثنا، وهي خطوة هامة لحصر مجال البحث في إطار محدد يقلل من تشتت مجهوداتنا وضياعها.
ان اختيارنا لموضوع ” الرواية المغربية المعاصرة: التعدد اللغوي والبوليفونية” يرتبط بدوافع ذاتية و أخرى موضوعية؛ من الناحية الذاتية، فعلاقتنا بموضوع التعدد اللغوي ليست حديثة العهد، فقد سبق لنا أن توقفنا عنده، وقفة خاصة، حين جعلنا منه بؤرة بحثنا لنيل دبلوم الماستر تحت عنوان “الإزدواجية اللغوية في الخطاب الإعلامي المغربي”. أما موضوعيا؛ فإن ما أحاط بمفهوم التعدد اللغوي والصوتي من علامات استفهام وما يعرفانه من بلبلة واضطراب منذ بداية ظهورها، وما يطرحانه من أسئلة وإشكاليات أثارت وما زالت تثير كثيرا من النقاش، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع، إذ لا يكاد يخلو مصنف من المصنفات المخصصة لتباحث قضايا الرواية العربية من إفراد مبحث على الأقل للخوض في قضاياهما وإشكالاتهما، يجعل الحاجة ملحة لإخضاع هذا الموضوع لمتطلبات البحث العلمي، خاصة وأن أغلب الباحثين لم يتوسعوا فيه ولم يتعاملوا معه بشكل معمق، كما أنهم لم يخضعوه للدراسة الأكاديمية العلمية إلا بعض الدراسات النادرة، ومن بينها:
– الرواية العربية الجديدة وإشكالية اللغة [1]– كتاب للناقد “عبد المجيد الحسيب” انصب فيه عمل الناقد بالأساس على التعدد اللغوي في الرواية العربية ممثلة في الروايات التالية: “ألف ليلة وليلتان” و ” الوباء” و “خضراء كالمستنقعات” لهاني الراهب، و “وكالة عطية” لشبلي خيري و ” شرف” لإبراهيم صنع الله. وما يجمع بين هذه الروايات، في رأيه هو أنها تؤشر على تجربة جديدة للخطاب الروائي العربي.
ويلاحظ أن الباحث قام بالبحث في مكونات الخطاب الروائي المشكل لهذه الروايات؛ وهي مسألة لم يكن النقد العربي يعيرها اهتماما كبيرا سابقا، مما يؤكد جرأة هذه الخطوة النقدية الجادة التي قام بها والتأثيرات الكبرى التي خلفتها وراءها. ونظرا لكون طموحنا لا يقتصر على أهم خصائص التعدد اللغوي، فإن بحثنا هذا يفسح لنا المجال في التعمق أكثر في ظاهرة تعدد اللغات والأصوات.
– تعدد الأصوات في رواية أشباح المدينة لبشير مفتي”[2] : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، للباحثتين “أميرة تايب” و “فيروز بشوع”. وقد عملا فيه نظريا على اتباع مكونات الخطاب الروائي بدء بالحوارية ثم الحوارات وتعدد أنماط الوعي بغية وضعها في سياقها العام ضمن مجموعة من الأسئلة التي تنظم حول سؤال أكبر وهو كيف نؤطر مشروع الرواية الجزائرية؟
وعلى صعيد التطبيق ترصد الباحثتان الموضوع من خلال قسمين أساسين وهما: القسم الأول اشتغلا على الأسلبة والتهجين والحوارات الخالصة، بينما اهتما في القسم الثاني ببنية الزمن والاسترجاع والاستباق، وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة، إلا أنها تشكو من عدم ربط التعدد اللغوي بجذوره وسعيها إلى تحديد مفهوم- التعدد اللغوي- في شموليته، وهو ما حرصنا على تحقيقه في بحثنا هذا، مما مكننا من تعميق البحث في هذا الموضوع.
وهناك دراسات أخرى تناولت هذا الموضوع نذكر منها:
– دراسة الناقد المغربي “حميد لحميداني” في كتابه “أسلوبية الرواية” الذي تناول فيه الصورة السردية البوليفونية.
– دراسة الناقد المغربي “محمد برادة” الذي تأثر بأعمال الروسي باختين فترجم كتابه ” الخطاب الروائي”، كما أنه اعتمد في روايته ” لعبة النسيان” تقنية تعدد الأصوات، و خصص حيزا كبير للتحدث عن التعدد اللغوي في الرواية ضمن كتابه “أسئلة الرواية أسئلة النقد” حينما تحدث عن ثلاث روايات و هي: “رحلة غاندي الصغير” لإلياس خوري 1989م ، ” سلطانة” لغالب هلسا 1987م ، “المركب” لطعمة فرمان 1989م.
ما يلاحظ على هذه الدراسات الجادة، هو محدودية المتن المدروس فيها، وهو أمر لن يسمح برصد تجليات التعدد اللغوي والتعمق في إشكالاته، لذلك عملنا على تجاوز ذلك انسجاما مع موضوع البحث من أجل تعميق البحث في ظاهرة التعدد اللغوي والصوتي في الرواية المغربية المعاصرة.
ولكي نبلور هذا الطموح اخترنا متنا راعينا فيه ما أمكن تمثيليته للظاهرة المراد دراستها، مع انسجامه مع التعريف الذي حددناه للتعدد اللغوي والصوتي. وبديهي أن البحث في الرواية المغربية المعاصرة يستدعي محاورة نصوص عديدة تمكننا من استخلاص خصائصه العامة. فهو يعكس تشعبا في الاختيارات الفنية التي توسل بها الروائيون لتجديد الرواية المغربية.
وقد كان اختيار نماذج معينة للدراسة أولى صعوبات البحث الحقيقية، إذ تطلب ذلك قراءة عدد كبير ومتنوع من الروايات، حتى تمكنا من الوصول إلى المتن المناسب الذي يتماشى مع موضوع بحثنا، ومنه، انصب اختيارنا على المتون التالية: “مجنون الحكم” ل”بنسالم حميش”، “ جارات أبي موسى” ل”أحمد التوفيق ” ، “ بنات ونعناع” و “عودة المرحوم” ل”حسن بحراوي”، ” لحظات لا غير” و”الحق في الرحيل” ل”فاتحة مرشد” ، “الأناقة” ” ل” الميلودي شغموم “، ويضاف إلى هذه الصعوبة، صعوبة أخرى، ترتبط بالمنهج. ذلك أن الاختلاف البين في الرهانات التعددية اللغوية للروائيين وتفاوت طرق اشتغالهم، إضافة إلى الطبيعة التعددية للنص الروائي والبنيات المختلفة التي يحتضنها، يجعل الاقتصار على منهج واحد في غاية الصعوبة، لذلك فقد توسلنا ببعض الأدوات المنهجية المستمدة من مناهج مخالفة للمنهج المعتمد في الدراسة، كما تطلب تحليل الرواية ذلك.
وبما أن مقصدنا في الشق التحليلي من البحث هو إبراز تمظهرات التعدد اللغوي وهي تمظهرات لا يمكن رصدها، إلا بالاعتماد على دراسة مكونات الرواية، التي خلالها يمكن توضيح التغييرات التي تمت على صعيد التحقق النصي، فقد بدا أن مجالات الدراسة الأدبية نشأ معها حيز فكري ومن ضمنها أعمال الناقد الروسي“ميخائيل باختين” التي تحتل مكانة متميزة في حركة النقد الحديث فهي نمت في كنف الشكلانية لكنها قدمت البديل النظري لها.
وهذا ما تبديه علم السرديات لنا؛ إذ تقدم للباحث عدة مفاهيمية يمكن أن يستند عليها في مقاربة مثل هذه، لذلك اعتمدنا على السرديات البنيوية، كما تبلورت من خلال الاتجاه البويطيقي، الذي يعتبر أن موضوعه ليس هو الجانب السردي للحكاية، وإنما المحكي باعتباره صيغة للتمثيل اللفظي للحكاية، وكما يقدم نفسه مباشرة للتحليل، إنه يدرس العلاقات بين المستويات الثلاثة التالية: المحكي، الحكاية، السرد. فما يهم الروائيين بشكل خاص هو الاختلاف المتعلق بالعمل الحكائي، ومكمنه في الخطاب، لأن المحتوى الواحد يمكن أن يقدم من خلال خطابات متعددة لكل منهما خصوصيته، فالمهم، بالنسبة لهم، هو العنصر الجمالي الكامن في هذا الاختلاف. هذا العنصر الجمالي هوالذي يصل الجانب السردي لدى السرديين بالأدبية، فالخاصية الأساسية لما هو سردي، حسب “جيرار جينيت”، توجد في الصيغة، وليس في المحتوى، إذ لا وجود للمحتويات الحكائية، هناك تسلل أفعال أو أحداث، قابلة لأن تتجسد من خلال أي صيغة تمثيلية.
منهجيا؛ ينطلق البحث من إشكالية أساسية لفهم وتفسير مدى اشتغال التعدد اللغوي والصوتي في الرواية المغربية المكتوبة باللغة العربية. ويروم الإجابة عن جملة من الإشكالات وهي:
- ما مدى اشتغال آليات التعدد اللغوي في الرواية المغربية العربية؟
- كيف تتفاعل الخطابات وتتحاور داخل المجموعة الروائية التخلق الحوارية والتعدد؟
- كيف تتصارع الإيديولوجيات وأنماط الوعي المختلفة لتعبر عن نفسها داخل المجموعة الروائية؟
- كيف رسم السارد الشخصيات الروانية وجعلها تنتمي إلى فئات اجتماعية متباينة لتختلف أساليبها ولغاتها وأصواتها وتعبر عن كينونتها؟
ولتحقيق هذه المرامي استعنا بخطة قسمنا بموجبها البحث إلى مقدمة ومدخل وبابين وفصول وخاتمة بالإضافة إلى فهارس عامة.
وإذا كنا في مدخل هذه الأطروحة تحدثنا عن المشهد الروائي المغربي من خلال طرح النماذج الروائية المستحضرة، واجتراح تقاليد فنية ثقافية شتى. عاملين في الآن ذاته على تحديد دور اتجاهات الرواية المغربية في رسم ملامح الخطاب الروائي المتعدد الأنماط واللغات لنخلص إلى رسم حاضره و تشييد مستقبله، فإننا عمدنا في الباب الأول الموسوم بـ” الخطاب الروائي: التعدد اللغوي والبوليفونية” إلى بسط أهم النظريات والمفاهيم التي بدت لنا أنها ستسعفنا في قراءة النماذج الروائية المختارة وتحليلها من زاوية التعدد اللغوي. وقد قسمنا الباب الأول بدوره إلى ثلاثة فصول. خصصنا الفصل الأول لعرض ومناقشة أهم الأفكار الخاصة ب”أسلوبية الرواية والرواية البوليفونية”.أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد خصصناه لمسألة “نحو تأصيل لمفهوم الحوارية في الخطاب الغربي والعربي”. وقد تناولنا هذه القضية انطلاقا من وجهة نظر “ميخائيل باختين” و آخرون وبينا كيف استطاع “ميخائيل باختين” أن يتجاوز التصور النفسي والإيديولوجي وكذا الشكلي الصرف مؤسسا تصورا مغايرا يعتبر فيه الشكل والمضمون شيئا واحدا داخل الخطاب المعتبر ظاهرة اجتماعية.
وخصصنا الفصل الثالث لموضوع “التعدد اللغوي في الرواية ” الذي يعتبر من أهم السمات التي تميز هذا النوع من الأدب، الذي يعتبر “دوستويفسكي” من أهم رواده. وبين فيه كيف اكتشف “باختين” من خلال “دوستويفسكي” شكلا جديدا في الفن الروائي؛ إنه الشكل الحواري المتعدد اللغات والأصوات، وهو شكل لا يعترف بالمقدس والنهائي، بل إن كل شيء لديه نسبي وغير مكتمل.
بعد هذا الطرح النظري، قمنا في الباب الثاني / التطبيقي الذي جاء تحت عنوان ” إشكالية اللغة في الرواية المغربية” بمقاربة التعدد اللغوي في النص الروائي المغربي من خلال دراسة تحليلية لنماذج روائية معينة، ولكي يتسنى لنا ذلك، قسمنا هذا الباب إلى أربعة فصول تناولنا في كل فصل نصين روائيين، بينما تناولنا في الفصل الرابع نصا واحدا.
وإذا كنا أفردنا الفصل الأول من هذا الباب للحديث عن “التعدد اللغوي في الرواية: التجليات والدلالة”، وقد خصص للتفاعل مع المكون التاريخي، وفيه درسنا رواية ” مجنون الحكم” للروائي “بنسالم حميش” و رواية ” جارات أبي موسى” للروائي أحمد التوفيق”، فإننا في الفصل الثاني المعنون ب ” تعدد المحكيات وطرق إشتغالها في الرواية المغربية” تناولنا النص الروائي المغربي من زاوية المحكي السردي، ولبلوغ هذا المسعى، عمدنا إلى دراسة روايتي ” بنات ونعناع” و ” عودة المرحوم” للروائي المغربي حسن بحراوي.
ثم انتقلنا بعد ذلك في الفصل الثالث إلى دراسة ” التداخلات اللغوية” من خلال التركيز على روايتي ” الحق في الرحيل” و ” لحظات لا غير” للروائية فاتحة مرشد.
وختمنا تحليلنا للمتون برواية ” الأناقة” للروائي ” الميلودي شغموم” توقفنا فيها عند “المحكي العجائبي في الرواية المغربية” أشكال حضوره وآلية توظيفه .
وفي ختام هذا الباب وضعنا خلاصات تبرز ما تحقق للرواية المغربية عبر الاشتغال بتقنية التعدد اللغوي.
وفي ختام هذا التقرير نسوق بعض من النتائج والخلاصات التي توصلنا إليها:
– تقف اللغة الروائية في رواية “جارات أبی موسی” باعتبارها نوعا من التأريخ المادة المتخيلة في مقابل تخييل المادة التاريخة في رواية “مجنون الحكم”، إذ يتم إضفاء الطابع التاريخي على حكاياته المتخيلة، عبر إقحام بعض المؤشرات التاريخية في طيات الحكي، من قبيل إبراز الطابع التاريخي لبعض فضاءاتها أو الإشارة إلى بعض الأحداث التاريخية الجزئية والتي لا ترقى إلى مستوى التأثير على كلية الحكاية.
– تفاعلت رواية “مجنون الحكم” باعتبارها نصا لاحقا مع التاريخ باعتباره نصا سابقا في إطار التعالق النصي، وذلك وفقا لمبدأي المحاكاة والتحويل البارودي اللذين يوضحان التوجه الدلالي الذي ينحو نحوه النص.
أما رواية “جارات أبي موسى” فقد تم تشييد عالمها الروائي عبر التفاعل مع تاريخ متخيل وافتراضي، وحضور بعض مظاهر الأحداث التاريخية يبقى محدودا مقارنة مع هيمنة الأحداث المتخيلة. الأمر الذي يسمح بتصنيفها ضمن المؤشرات التي تكشف عن المظهر التاريخي للحكاية فقط. فالحكايات المروية أغلبها حكايات متخيلة، وما يبرز مظهرها التاريخي هو تلك المؤشرات التي تتخللها، مما يجعل من مبدأ التفاعل الذي يقوم عليه النص تفاعلا افتراضيا.
– تأسست رواية “جارات أبي موسى” على محاكاة أسلوب الكتابة التاريخية، وهذا ما يجعلها تدخل في علاقة تفاعل مفترضة مع كتابة تاريخية، وذلك عبر إيهامها بأن وظيفتها هي الإخبار الذي يتداخل مع مقصدية المؤرخ من الحكي، لكن يظل هذا الإيهام على المستوى السطحي للرواية، إذ بمجرد تجاوزه إلى المستوى العميق تتفجر أسئلة أخرى بحثا عن الدلالة الخفية التي يحملها الخبر بعيدا عن المظهر الإخباري- التاريخي للنص.
– يتحدد اختيار التاريخ للتفاعل معه في التأسيس للغة وصوت الكتابة الروائية باعتبارها اختيارا جماليا تعبيريا يتيح القدرة على التعامل مع الواقع، أكثر مما قد تتيحه الرواية الواقعية، في ظل المحرمات والممنوعات. وما يسمح بهذه الإمكانية هو التماثل الذي يصادفه الروائيون بين ما يجري في الواقع وبين أحداث وشخصيات في الماضي. فالتفاعل مع التاريخ، في الروايتين، لم يأت بشكل اعتباطي وعفوي، وإنما بهدف ملامسة أعمق وأكثر تحررا لقضايا الواقع عبر توفير أفق أخصب للحوار وتعدد اللغات.
– التفاعل النصي يتيح للكاتب تلقيح رواياته بتقنيات وأساليب السرد الذي يجعل من النص شيئا مختلفا عن سابقه شكلا ومضمونا. وقد كان موضوع دراسة “بنات ونعناع” طريقة جديدة ومختلفة في الكتابة إذ، أنه أسند البطولة لصوت نسائي وهي عملية ليست بالبسيطة إذ أنها تتطلب معرفة نفسية عميقة بالخصوصيات الحميمية للمرأة بما فيها الأشياء الأكثر التصاقا بها كذات تعاني من حيف الثقافة الرجولية التي تجعل منها كائنا من الدرجة الثانية. وقد وفق حسن بحراوي في تشخيص هذا الصوت الأنثوي التواق للحرية والانعتاق من سلطة التقاليد القديمة والبالية إلى درجة أن صوت الشخصية ظل ينمو ويتطور بشكل مستقل عن سلطة الكاتب ويمنح الانطباع بأن كاتب هذه الرواية، البطلة ذاتها وليس حسن بحراوي .
– تشخيص الرواية المغربية العديد من الأصوات الاجتماعية والمهنية والسياسية … كما أنها ظلت فضاء لتصارع رؤى أساسية للعالم .
– احتفاء النص الرائي بمجموعة من اللغات ومن بينها نجد اللغة المهنية التي تصدر عن مجموعة من العمال والموظفين في قطاعات، ولغة الساحة العمومية وهي لغة صادرة من قاع المجتمع ومعبرة عن ثقافة الفئات الاجتماعية التي تعيش في القاع الاجتماعي المهمش. ولم يكتف النص الروائي بهذه اللغات فحسب، بل احتفى بلغات أخرى وعمل على تشخيصها وإخراجها من منطقة المحرم والمسكوت عنه ودفع بها إلى التعبير عن نفسها بكل حرية.
– التوجيه الذي مارسه الكاتب على بعض الحوارات لبعض الشخصيات، قد جعل العديد من الأصوات ألا تعبر عن غيرتها الحقيقية، بل غذت معبرة عن رغبات الكاتب و أفكاره فدمرت الثنائية الصوتية، غير أن الكاتب بدل التعامل مع هذا الميراث في الحدود المتعارف عليه، فقد حوله إلى مجال للحديث عن التراث والهوية والماضي فأصبحت حوارات الشخوص حول الميراث أقرب منها إلى الحديث عن مزايا تراث الأجداد وأهمية التشبث بالجذور.
تركيز النص الروائي على إبراز الثنائية الصوتية الحادة التناقض والمتمثلة في صوت الدولة من جهة باعتباره صوت السلطة الآمرة والقمعية، والأصوات المضطهدة من جهة ثانية، والذي مثله مجموعة من الشخصيات الذين توحدهم خلفية معرفية وايديولوجية مغايرة لما هو سائد.
ناهيك عن تميز هاذين النصين لحسن بحراوي بمجموعة من الصفات الجمالية وبلورة رؤية معرفية روائية تجلت في:
- الانزياح عن الأشكال القديمة المتسمة بالتسلسل الخطي للحكاية والتوالي الكرونولوجي للزمن والتركيز على بطل رئيسي إشكالي .
- تشييد أشكال وطرائق جديدة في الكتابة تسعى إلى تفجير اللغة وتشظية الأحداث ومساءلة الزمن.
- الاحتفاء بالتعدد الصوتي واللغوي كطريقة تسعى إلى تنسيب الأفكار والآراء وتشخيص الرأي والرأي الآخر وتعمل على تقويض الأحادية والوثوقية الواهمة.
- تجاوز السارد العالم بكل شيء وتقديم السرد من وجهات نظر متعددة ومتباينة حتى يتمكن القارئ من النظر للأشياء من مختلف زوايا النظر.
- تنوع في المرجعيات النصية يدل على سعة إطلاع الكاتب من جهة كما يدل على أن نظرته لمسألة الحداثة ليست مرتبطة بزمان أو مكان ما، بل هي رؤية إبداعية عميقة .
- حسن بحراوي من الكتاب الذين يتجاوزون أنفسهم باستمرار فهو لا يركن إلى شكل أو طريقة في التعبير نهائية بل إنه في كل نص نجده يجرب طريقة تختلف بشكل كبير عن طريقته.
- لقد كان حسن بحراوي يعمل بين الحين والآخر على تحرير الكتابة من سلطة العقل منفتحا على منطقة اللاشعور والهذيان ولغة الأحلام وأحلام اليقظة.
- ينتمي حسن بحراوي إلى جيل من الكتاب عملوا بشكل كبير على تطوير السرد المغربي.
– اعتماد الرواية لغة تميل إلى فضح وتعرية الواقع بغية تجريده من مختلف الأقنعة التي تخفي ما يضمره من تشوهات وفظاعات حكمت على القطاعات العريضة من أبناء الشعب المغربي. من خلال تعدد المستويات اللغوية في الخطاب السردي عبر تهجين لغة الخطاب التي جمعت فيها من الفصيح والعامي المغربي واللغة الغربية، وذلك من خلال استيحاء للتراث الغربي وتوظيفه أو من خلال تثقيف النص الروائي بتجارب المفكرين.
– صارت العامية مرجعية دالة على الخطاب المغربي اليومي، و الأجنبية تمثل فضاء النخبة ذات الثقافة الفرنسية مما جعل هذه اللغة تتجاوز كونها مجرد ألفاظ من القاموس اللغوي، لتصبح أداة يتم توظيفها في النص الروائي الشامل للخطابات المتداخلة والأصوات المتعددة الحاملة للمعاني الجديدة التي فرضتها سياقات الواقع ، الذي يستمد روافده من الإرث الحضاري والثقافي.
– محاورة الرواية المغربية أحداثا، وشخصيات ولغات؛ لم تكن استلابا ولا انبهارا بالأشكال السردية العتيقة التي تكتنزها ، بقدرما كانت تفاعلا إيجابيا استطاع الروائي المغربي من ورائه بنية النص المتعدد اللغات، وذلك بما يتوافق وإكراهات اللحظة، وما تقتضيه من من إعادة النظر في كل المصادر الجاهزة، وما تستوجبه كذلك من إخضاع كل المنجزات الإنسانية، بما في ذلك المنجز الروائي المتعدد الأنماط والخطابات، إلى المساءلة النقدية التي تقود إعادة الإعتبار للرواية جماليا، وذلك بعد تشريحها وتقويمها وإعادة بناء العناصر التي تتخللها.
– توظيف الرواية التعدد اللغوي، وكان هذا التوظيف ظاهرة فنية وليدة، لعبت دورا محوريا في وسم الإنتاج الروائي المغربي بسمات شكلية ودلالية متميزة.
– تقديم رواية “الأناقة” كتابة روائية تنزاح عن الكتابة التقليدية، وذلك عبر الشخصيات والتنويع اللغوي والثيمي والتراكب الحكائي، وعبر الميل إلى الحفر في التاريخ الأسطوري، مما جعلها تكرس تشخيصا جماليا وفنيا مغايرا لمقتضيات الواقع.
– حرص الروائي على تقديم مادة روائية قادرة على إيقاظ القارئ وشده إليها، فإنه يقدّم رواية محبوكة تنم عن دربة ومراس متميزين تثير فضول محفل المتلقي وتشده إليها عن طواعية، فالرواية القائمة على التشويق والإثارة في مستوياتها اللغوية المتعددة هي الجديرة بالاستهلاك، ولكي تكون عملا ناجحا ، يجب أن يكون لها المفعول النقيض للمُنوّم والروائي بإصراره على استثمار النهاية المفتوحة، فإنه يصر على تمديد زمن الرواية في وعي القارئ لكي يمنح له فرصة الاشتراك النشط في سد الثغرات وملء الثقوب والفراغات التي تبقى بدون تدخله قائمة في أفق إنتاج الدلالة العامة للنص التي ستبقى هي الأخرى نسبية وغير مكتملة ومفتوحة.
– لقد استطاعت الرواية أن تتخلص من الطابع الأطروحي بفضل أجوائها الأسطورية والعجائبية، فعلى عكس العديد من النصوص الأخرى. فقد عملت – رواية الأناقة – على تعويم المحكي الواقعي وسط محكيات عديدة فحافظت بذلك على هامش من الحرية لمختلف الأصوات واللغات، كما عمل البعد العجائبي في النص على التخفيف من حضور الواقعي وهيمنته على النص الذي جاء كظفيرة تحوي عددا هائلا من المحكيات واللغات والأصوات.
– على الرغم من العيوب التي رافقت الأديب المغربي والمتمظهرة أساسا في سيادة طابعي النمطية والغموض، واستدعاء عناصر متنافرة من الشخصيات والأحداث التاريخية والدينية والأسطورية والرمزية؛ فقد تمكن الأدب المغربي بفضل انفتاحه على الحوارية والتعدد اللغوي من اكتساب ملامح فنية و إنسانية أسعفته في التعبير بصدق عن راهن عصره، وتطلعات مجتمعه.
– وبعودتها إلى التاريخ، تمكنت الرواية المغربية من التحرر نسبيا، من الطابع المعياري الغربي، الذي حول العديد من الأعمال الروائية العربية بصفة عامة، إلى تمارين سردية مجردة، اجتهدت في تحويل أعمالها الروائية إلى تطبيقات نصية للنظريات السردية الغربية مما أسقطها في العديد من المطبات التي أضعفتها فنيا وجماليا. من هنا طرحت الرواية المستلهمة للغات المتعددة كخيار فني قادر على تخصيب التجربة الروائية المغربية.
– لقد نجحت الرواية المغربية إلى حد بعيد، ليس في التعبير عن قضايا إنسانية وحضارية شائكة فقط، وإنما نجحت كذلك في نوع من الجدل الفكري والفلسفي والفني وبين ماهو شرقي وغربي.
– منحت الحكاية الخرافية للروائي إمكانات تعبيرية وجمالية أكبر، فقد تمكن عبر محاكاته الجادة أو البارودية، للنص الحكائي الخرافي في أن يمرر خطابه الإنتقادي إزاء ما عرفه الواقع السياسي والثقافي والإجتماعي المغربي مع تمييع الفساد.
– لم يقم السرد الروائي المغربي باجترار التاريخ، إنما قام بخلق لون من الحوارية والجدل بين المكونات التخييلية والعناصر المرجعية، جدل لم يتم على مستوى الحدث والشخصية ووجهت النظر والزمن والفضاء فحسب، وإنما تم على مستوى اللغة الروائية .
هذه إذن أهم الخلاصات والنتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث.
– وأكيد أنه بمرور الوقت، واتساع الرؤية، وتعمق الوعي النقدي أكثر بالظاهرة / موضوع الدراسة؛ ازدادت حدة الإحساس بنسبية ما توصلنا إليه من نتائج، إحساس لم يخفف من وطأته إلا اقتناعنا بأن أهمية البحث، لا تكمن في حجم ما توصل إليه من نتائج وخلاصات فقط، بل أيضا بمدى قدرته على تحويل الطروحات الجاهزة إلى أسئلة إشكالية وجادة تقود إلى إعادة قراءة الواقع الروائي العربي قراءة صحيحة.
– إننا لا ندعي أننا أحطنا بكل حيثيات ظاهرة التعدد اللغوي في الرواية المغربية. فحسبنا أننا ألمعنا إلى أهمية التعدد اللغوي، وأن مناقشته في الإطار الأدبي والفني لا تخلو من إشكالات جادة وعميقة نأمل أن تشكل لبنة وأساسا لبحوث ودراسات مستقبلية.
[1] – عبد المجيد الحسيب، الرواية العربية الجديدة وإشكالية اللغة ، عالم الكتب الحديث، ط1، الأردن، 2014.
[2] – أميرة تايب – فيروز بشوع، تعدد الأصوات في رواية أشباح المدينة لبشي مفتي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا (الماستر) تحت إشراف د.روفيا بوغنوط، كلية الآداب واللغات، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 2017.


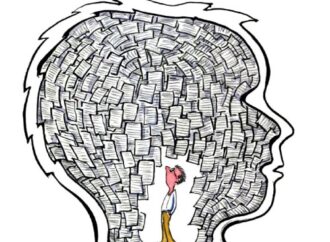

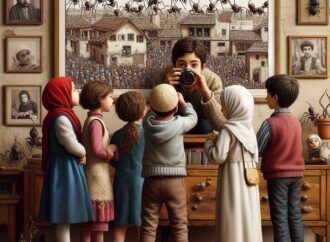
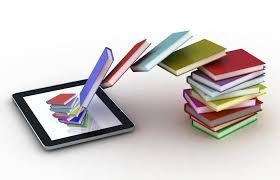
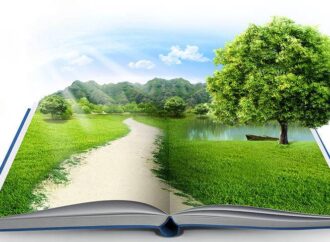






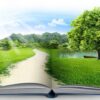
1 التعليق
badr abaissa
10/02/2025, 12:36 صتحية للأستاذ الباحث سي محمد الغمروسي على هذا إثارة هذا الموضوع المهم . فقط لدي سؤال بسيط ، وهو : هل رواية المغربية بالفعل ما تزال تنصت للواقع وتطرح أسئلة حقيقية على المستوى اللغوي والاجتماعي والسياسي … إم انها لا تعدو روايات تناقش موضيع سطحية لا تركز سوى على الجانب الجمالي والتعبيري ان صح القول ؟
الرد