الشغب لدى المتعلمين المراهقين وأثر التربية على القيم في معالجته
الطالب الباحث: بوسلهام هرو ( مختبر علوم الاديان) كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة ابن طفيل / القنيطرة- المغرب
إشراف الأستاذ: الدكتور محمد بن كيران، ( مختبر علوم الاديان) كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة ابن طفيل / القنيطرة- المغرب
تقديم
بســــــــم اللــه الرحمـــن الرحيـــــم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وبعد:
لقد أولى شرعنا الحنيف مكانة سامية للأبناء، وأعطاهم عناية خاصة على مستوى التربية والتعليم والرعاية، والسر في ذلك أن الأبناء هم الكفيل الوحيد لاستمرار العنصر البشري، الذي جُعل خليفة الله في أرضه، وسخر له من النعم ما لا يعد ولا يحصى، والأبناء هم رجال المستقبل ومنارة الإصلاح.
والهدف من البحث في هذا الموضوع الإسهام في إيجاد حلول للحد من الشغب في صفوف المتعلمين المراهقين، الذي يشغل مجموعة من الفاعلين في المنظومة التعليمية بدءاً بالمدرس، ثم إدارة المدرسة وأعوانها، والمجالس التربوية و التعليمية، والمجتمع بكل مكوناته.
إذا لم نقدم لأبنائنا المتعلمين الرعاية الكاملة، والتربية والتعليم النموذجيين، سيكونون عرضة للضياع، وعنواناً للفساد في الأرض، وسيتحمل المسؤولية الجميع، وعلى رأسهم العلماء والمربون، لأنهم لم يقوموا بواجبهم العلمي والديني والأخلاقي.
وسبب البحث في هذا المجال أن فترة المراهقة مرحلة تختلف عن باقي المراحل التي يعيشها المتعلم، لأنها مرحلة الانفعالات والاضطرابات التي تسبب الشغب أثناء ممارسة العملية التعليمية التعلمية، ومن أجل إيجاد بعض الحلول للحد من ظاهرة الشغب في صفوف المراهقين.
الإشكالية: هل الشغب لدى المتعلم المراهق أمر طبيعي؟ وهل التربية على القيم يمكن أن تسهم في الحد منه؟
هذا وإني قد قسمت موضوع بحثي إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، وقد تناولت في المقدمة أهمية وأسباب اختيار الموضوع، وجعلت الفصل الأول في مبحثين، بعد أن مهدت له بمدخل مفاهيمي، تحدث في المدخل عن المصطلحات الواردة في عنوان البحث من الجانب اللغوي، وفي المبحث الأول عن مرحلة المراهقة، والمبحث الثاني عن مميزات المراهقة، وأما الفصل الثاني فقسمته إلى مبحثين، تكلمت في المبحث الأول عن الشغب وأنواعه، والمبحث الثاني عن القيم والمعالجة، وأما الخاتمة فتناولت فيها خلاصة ما سبق ذكره في البحث.
الفصل الأول: مرحلة المراهقة ومميزاتها
مدخل مفاهيمي:
- الشغب: “شغب: قال الليث: الشغب: تَهَيُّجُ الشّر، وأنشد:
وإنِّي عَلَى مَا نَالَ مِنِّي بِصَرْفِهِ على الشَّاغِبِينَ التّاركي الحَقِّ مِشْغَبُ
يقال للأتان، إذا وحمت، فاستعصعت على الفحل: ذات شغب وضغن[1]. وقال صاحب مقايس اللغة “(شغب) الشين والغين والباء أصل صحيح يدل على تهييج الشر، لا يكون في خير. قال الخليل: الشغب: تهييج الشر، يقال للأتان إذا وحمت واستعصت على الجأب: إنها لذات شغب وضغن. قال أبو عبيد: يقال شغبت على القوم وشغبتهم وشغبت بهم”[2].
كما أن الشغب جاء بمعنى المكان، وفي حديث الزهري «أنه كان له مال بشغب وبدا» هما موضعان بالشام، وبه كان مقام علي بن عبد الله بن العباس وأولاده إلى أن وصلت إليهم الخلافة. وهو بسكون الغين”[3].
ومما ينبغي الإشارة له أن مصطلح الشغب بتسكين الغين هو المقدم عند أهل اللغة كما ذكرنا، ولهذا قال فيروز آبادي: “الشغب، ويحرك، وقيل لا: تهييج الشر”[4].
هذا مفهوم الشغب عند أهل اللغة، أما الشغب كظاهرة تربوية سنتحدث عنها إن شاء الله في المبحث الثاني.
- المراهقين: جمع مراهق “راهق يراهق، مراهقة، فهو مراهق، راهق الغلام: قارب الحلم وبلغ حد الرجال “رأيته غلاما مراهقا نضج تفكيره وتخطى مرحلة المراهقة” جنوح المراهقين: تصرف إجرامي أو غير اجتماعي من قبل الأحداث أو المراهقين- شاب مراهق: بين البلوغ وسن الرشد”[5].
- التربية:” التربية: إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام”[6]. ويقال: ” التَّرْبِيَةِ، رَبَوْتُ فِي بني فلانٍ، أربُو رَبْوَاً، ورَبيتُ أَرْبَى لُغَةً. وربَّيْتُ الصبيَّ تربيةً، وربَّبْتُهُ تربيباً، وربَّيْتُ السِّمسمَ تربيباً، وربَّيْتُ النِّعمةَ، بالتخفيفِ أَرُبُّهَا رَبَابَةً، إِذَا تَمَّمْتَها”[7].
- القيم: “والقيم: مصدر كالصغر والكبر إلا أنه لم يقل قوم مثل قوله: “لا يبغون عنها حولا”؛ لأن قيما من قولك قام قيما، وقام كان في الأصل قوم أو قوم، فصار قام فاعتل قيم، وأما حول فهو على أنه جار على غير فعل؛ وقال الزجاج: قيما مصدر كالصغر والكبر، وكذلك دين قويم وقوام. ويقال: رمح قويم وقوام قويم أي مستقيم؛ وأنشد ابن بري لكعب بن زهير:
فَهُمْ ضَرَبُوكُم حِينَ جُرْتم عَنِ الهُدَى … بأَسْيافهم، حتَّى اسْتَقَمْتُمْ عَلَى القِيَمْ
وَقَالَ حَسَّانُ:
وأَشْهَدُ أَنَّكَ، عِنْد المَلِيكِ، … أُرْسِلْتَ حَقّاً بِدِينٍ قِيَمْ
قَالَ: إِلَّا أَنَّ القِيَمَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الِاسْتِقَامَةِ” [8].
يمكن القول بأن القيم هي الاستقامة والسلوك الحسن الذي يرضاه الخالق سبحانه، وتهواه النفوس الطيبة وتتحلى به.
المبحث الأول: مرحلة المراهقة
قبل الحديث عن مرحلة المراهقة ومميزاتها، يجب علينا أن نعرج عن النمو وخصائصه، وأن نشير إلى وقت المراحل الأخرى في عمر الإنسان، لأن المراهقة مرحلة من مراحل النمو التي يعرفها الشخص أثناء عبوره في الحياة.
تعريف النمو: يمكن تعريف النمو بأنه: تتابع لمراحل معينة من التغيرات التي يمر بها الكائن الحي في نظام واتساق.
و”المقصود من النمو هو التطور الذي يلاحظ على الإنسان من حيث التغيرات التي تحدث في بنيته الجسمية وطاقته العقلية وسلوكه الانفعالي وعلاقاته الاجتماعية “[9].
خصائص النمو
لقد ذكر الباحثون في مجال التربية خصائص للنمو، يقول علي أحمد مذكور في كتابه -مناهج التربية الإسلامية أسسها وتطبيقاتها- “من أهم خصائص النمو ما يلي:
– أنه نتيجة للتفاعل بين العوامل الوراثية والخبرات المكتسبة من البيئة المحيطة، بما في ذلك الخبرات التربوية، وبذلك فالإنسان لا يصل بالنمو إلى درجة كماله الإنساني نتيجة للعوامل الوراثية وحدها، بل لا بد من تفاعل هذه العوامل مع العوامل البيئية بصفة عامة، والعوامل التربوية بصفة خاصة.
– أنه متصل اتصالا وثيقا بالنضج، فالنمو لا يسير في الاتجاه الصحيح ولا بالسرعة المطلوبة إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة النضج المناسبة لذلك، فنمو الطفل في تعلم المشي أو القراءة أو الكتابة لا يسير في سهولة ويسر إلا إذا وصلت الأعضاء الخاصة بذلك إلى مرحلة النضج المناسبة.
– أنه يتجه من العام إلى الخاص، فكل الحيوانات والنباتات بدأت خلية واحدة، ثم انقسمت إلى أعضاء متمايزة.
– أن هناك فروقا فردية في النمو، فالأفراد جميعا لا ينمون بدرجة واحدة، كما أن درجات النمو الجسمي والعقلي والنفسي للفرد الواحد لا تسير بسرعة واحدة”[10].
من خلال هذه المراحل يظهر أن انتقال الإنسان من مرحلة إلى مرحلة يكون تدريجياً وليس فجائيا، وما يخصنا منها هو مرحلة المراهقة، حيث قسمها العلماء إلى ثلاثة مراحل، مراهقة مبكرة، وتكون من السنة الثانية عشر إلى السنة الرابعة عشر، ويكون التلميذ في الطور الإعدادي، ومراهقة وسطى، وتمتد من السنة الخامسة عشر إلى السنة السابعة عشر، ويعيشها في مرحلة الثانوي، ومراهقة متأخرة وتكون من السنة الثامنة عشر، إلى سنة الواحد والعشرين، حيث يكون المتعلم في الدراسة الجامعية، وعموماً فإن مرحلة المراهقة مرحلة حساسة، وتختلف اختلافا بيناً عن باقي المراحل الأخرى، لأن “المراهقة هي مرحلة الشباب المتدفق، مرحلة عنفوان شباب المستقبل، وهي مرحلة التطورات السريعة، تطرأ على كيان المراهق كله جسمياً ونفسياً وجنسياً.. وما المراهقة إلا مرحلة من مراحل العمر المختلفة، لها خصائصها ومميزاتها ومشكلاتها، شأن كل مرحلة كالطفولة أو الكهولة؛ ولذلك لا بد من التعامل مع هذه المرحلة على أسس علمية مدروسة، بعيداً عن التخبط والارتجال؛ ذلك أن الشباب أمل الأمة، ومعقد آمالها”[11].
المبحث الثاني: مميزات المراهقة
يتميز المراهق بتمركزه على ذاته وتحقيق طلباته، من أجل إثبات وجوده، واهتمام الآخرين لما يفعله، ولأن “المراهق أيضًا ممركز حول ذاته، ولكن على طريقة أخرى غير طريقة الطفل، ثم إنه -مع اهتمامه الشديد بذاته، ورغبته الشديدة في أن يظل اهتمام الآخرين متعلقًا به- فإن له مشاعر كثيرة يتوجه بها نحو الآخرين، ويهتم فيها بأشخاصهم.
إن الطفل -في تمركزه حول نفسه- يظل يستخدم الآخرين لتحقيق طلباته؛ لأنه بطبيعة الحال لا يملك أن يلبي لنفسه كل ما يريد من حاجات، وإن ربي تربية استقلالية وعود منذ صغره الاعتماد على نفسه، أما المراهق فإنه -في تمركزه حول نفسه- يريد أن يثبت وجوده، يريد أن يهتم الناس به لما يفعله هو لا بما يفعله الآخرون له، إنه -في خياله أو في وهمه- بطل، إنه خارق القدرة، إنه حدث تاريخي، وهو يريد من الناس أن يعرفوا بطولته الفائقة هذه ويقروا بها، ولذلك فهو يحاول لفت نظرهم دائمًا بما يأتي من الأعمال التي يراها خارقة وغير مسبوقة، ولا شك أن المراهق المسلم شيء آخر”[12].
يختلف الحديث عن مرحلة المراهقة بين النظرة الغربية لدى علماء الغرب، وما ينحوا نحوهم، وبين علماء المسلمين المتخصصين في علم نمو الطفل، فالنظرة الغربية تنظر إلى هذه الفترة أنها مرحلة حلم طويل، وأن المراهق غير مؤاخذ بأفعاله، لأنها فترة قلق واضطراب، تهز كيان المراهق وكأنه مريض، ولا حرج عليه، بينما الرؤية الإسلامية لهذه المرحلة تخالف هذا الرأي، وترى أن المراهقة هو تغيير يعرفه الشخص، ينتقل به من مرحلة الطفولة إلى مرحلة التكليف والرشد، له حقوق وعليه واجبات.
ولهذا نرى شباباً في التاريخ الإسلامي رغم حداثة سنهم حققوا أشياء ما زلنا نستفيد منها إلى زمننا اليوم، أمثال عبدالله بن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، وحتى في وقتنا اليوم نجد كثيراً من المراهقين نماذج في دراستهم وسلوكهم.
وهذا لا يعني أن نترك المراهقين وحدهم بدون توجيه وإرشاد، ولا نعينهم على هذه المرحلة الانتقالية، وبالأخص في ظل هذه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة التي وصلت إلى كل مكان.
هذه القراءات المختلفة لمرحلة المراهقة، وكيفية التعامل معها تؤكد لنا أنها ليست كباقي المراحل في نمو الإنسان، ولهذا نرى الشغب لدى المتعلمين المراهقين حاضراً بقوة.
الفصل الثاني: الشغب وأسبابه ودور القيم في معالجته
المبحث الأول: الشغب وأسبابه
قد عرفنا الشغب في المدخل المفاهيمي بأنه تهييج الشر والفتنة، وهذا المعنى اللغوي للشغب قريب من مفهوم الشغب في المنظومة التربوية، وذلك من خلال الاطلاع والاستقراء لكلام الباحثين التربويين، نجد أن الشغب بأنه ظاهرة تربوية، يكون صاحبه مفعما بطاقةٍ حيوية يستخدمها التلميذ في الجانب السلبي عوض استغلالها وتفريغها فيما ينفعه، وهذا السلوك قد يؤثر على السير العام للفصل الدراسي، ويحدث مشاكل داخله، ويفوت الاستفادة والتركيز لدى المتعلمين.
أسباب الشغب
يعتبر الشغب الصفي ظاهرة قد لا تكاد تخلو منها مؤسسة تعليمية إلا ناذراً، والشغب له أسباب كثيرة، منها ما يعود إلى المدرس والمدرسة، ومنه ما يرجع إلى المتعلم، وهذه الأسباب كالآتي:
أولا: عدم معرفة المدرس لواقع المراهق والمرحلة التي يعيشه.
ثانيا: عدم التحضير الجيد للدرس، لأن الارتجال قد يكون سبباً رئيساً في الشغب لدى المتعلمين.
ثالثا: اعتماد المدرس أسلوب التلقين أو المحاضرة، أو يعتبر نفسه هو صاحب المعرفة وحده، ولا يشرك المتعلمين في بناء التعلمات، ويبقى المتعلم في هذه الحالة مستهلكا للمعرفة، ولا يسهم في إنتاجها.
رابعا: ضعف تكوين المراهق في المراحل الدراسية السابقة للأسباب ذاتية، أو موضوعية، مما يفقده المتابعة الصفية على الوجه المطلوب.
خامسا: وسط المتعلم الاجتماعي والبيئي، أحيانا قد يكون لدى المراهق مشاكل أسرية ولا ينتبه لها أحد، أو أنه يعيش في مكان معروف بالشغب.
سادسا: عدم الانتباه للاضطرابات والانفعالات البيولوجية التي يعيشها المتعلم في مرحلة المراهقة.
سابعاً: الرفقة السيئة، لأن الصاحب إما أن يكون له تأثير سلبي أو إجابي.
ثامنا: قلة الفضاءات والأنشطة الموازية التي تستغل في توظيف طاقة المراهق فيما ينفعه.
تاسعاً: عدم تفعيل خلية الإنصات أو عدم وجودها أصلاً في بعض المؤسسات.
عاشراً: عدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة.
قد تكون أسباب أخرى غير ما ذكرناه ولكن هذه أهمها، ويعد العمل على عدم وجود هذه الأسباب حلاً يعالج، ويحد من الشغب لدى المتعلمين المراهقين، غير أن هذه الحلول يشترك فيها مجموعة من الفاعلين، وهذا ما سنراه في المبحث الموالي.
المبحث الثاني: القيم والمعالجة
المراهق الذي نحن مطالبون بتدريسه له ميولات ورغبات نفسية، ينبغي أن نراعي الطبيعة النفسية للمراهق أثناء تقديمين للدروس التعليمية، حتى تعطي التعلمات المقدمة للمراهق أكلها ونتيجتها المطلوبة.
والحلول المقدمة للحد من ظاهرة الشغب لا تقتصر على جهة واحدة، بل ينبغي أن يسهم فيها الجميع من أسرة، ومدرسة، ومدرس، وباقي الفاعلين في المنظومة التربوية، ويمكن لنا أن نحدد بعض المهام القيمية لكل طرف من أجل الإسهام في الحد من الشغب لدى المتعلمين المراهقين، وإبعادهم عن العناد والمكابرة وحب الذات.
دور المعلم في الحد من الشغب
تتمثل مهمة المربي في تهذيب أخلاق المتعلم، ومعرفة حاجاته، والإجابة عن الإشكالات التي يعيشها.
وينبغي أن يكون قدوة للمتعلم في التحلي بالقيم والأخلاق الجميلة من الصبر وتحمل الأذى، والرفق وغيرها من الأخلاق السامية التي يكون لها أثر إيجابي على المتعلم، وأن يكون المربي له معرفة بالوسط الذي يعيشه التلميذ، وأن يشركه في بناء التعلمات، وأن يبث فيه حب الخير للغير، والتعاون مع الأصدقاء في كل ما ينفعهم، ويحسن من مستواهم التربوي والتعليمي، وأن يحبب له الدراسة من خلال إعطاء نماذج من الشباب الذين كان لهم دور كبير في نشر رسالة الإسلام، منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا اليوم، أمثال عبدالله بن عباس الذي يعد من أكبر المفسرين للقرآن الكريم، والأرقم بن أبي الأرقم الذي كانت داره أول مدرسة في الإسلام، ومعاذ بن جبل الذي كان سفير رسول الله إلى اليمن وغيرهم، وأن يشعره بالمسؤولية في ذلك، وأن يشجعه وينوه به إن ظهر له منه شيء إيجابي، لأن المتعلم في هذه المرحلة يجب الثناء والمدح.
ينبغي للمدرس أن يستحضر مراقبة الله وأن يخلص في عمله، وأن يتزود بالعلم والمعرفة، وأن لا يتوقف في تطوير كفاءته المهنية على جميع المستويات، وقبل أن يبث قيم الإسلام في صفوف المتعلمين لابد وأن يعيشها، ويتصف بها في حاله ومقاله، لأن دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال.
هذه القيم إذا كانت متوفرة في المدرس فأكيد أنها ستنتقل إلى المتعلم تلقائيا، وستسهم في الحد من الشغب عند المراهق.
مهام الأسرة
الاحتضان والرعاية، والتربية بالقدوة الحسنة، ومعرفة اهتمامات المراهق وأصدقائه، وتحذيره من رفقاء السوء، لأن الصحبة إما يكون له أثر إيجابي أو سلبي، لقوله صلى الله عليه وسلم “المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل”[13].
ينبغي للأبوين تذكير المراهق باحترام معلميه وأصدقائه والطاقم الإداري، لأنهم جميعاً في خدمة مصلحته، وينبغي السؤال عن المتعلم لدى معلميه، لمعرفة مستواه الدراسي والأخلاقي داخل الصف، والغرض من السؤال هو التعاون على مصلحة المتعلم، وتهذيب سلوكه، والحد من الشغب، الذي قد يكون عائقاً في تقدم مستواه الدراسي.
مهام المؤسسة
إذا قامت المؤسسة التعليمية بالمهام المنوطة بها من إدارة وحراس، وقاعات دراسية في المستوى المطلوب، وقاعات للأنشطة الموازية، ومسابقات ثقافية، وقانون داخلي يحترمه الجميع، فأكيد أن هذه الأمور ستعطي ثمارا طيبة، تنعكس على المراهق، وتسهم في الحد من الشغب، وأن ترفع الإدارة من شأن المدرس في عيون متعلميه، لتكون كلمته وتوجيهاته مسموعة أكثر.
الخاتمة
يمكن القول بأن الشغب ظاهرة تربوية لا تكاد تخلو منها مؤسسة تعليمية، ويتأكد هذا عند المتعلمين في مرحلة المراهقة، حيث يكون المتعلم فيها يعيش اضطرابات نفسية، وفيزيولوجيا، تفقده أحيانا المتابعة في الصف الدراسي بجد وحزم ومسؤولية، والشغب له أسباب متعددة، منها ما يعود على المدرس لأسباب قد تكون معرفية وبيداغوجيا، ومنها ما يرجع إلى المؤسسة، لكون بعض المؤسسات لا يوجد فيها فضاءات للأنشطة الموازية، والثقافية لتفريغ هذه الطاقة الحيوية لدى المتعلم المراهق، كما أنها لا تسن أو لا تفعل قوانين يحترمها الجميع، وهناك أسباب ترتبط بالمتعلم قد تكون نفسية أو اجتماعية أو بيئية.
ومن الحلول التي يمكن أن تعالج هذه الظاهرة لا بد من تربية المتعلم على القيم الإسلامية والأخلاقية، من الصدق، والوفاء بالأمانة، والورع، والمسؤولية، والقدوة الحسنة، والعفة، والمروءة، والاعتراف بالجميل، وغيرها من القيم، وينبغي إشعار المراهق بالمسؤولية تجاه نفسه وخالقة والمحيطين به، وينبغي أن يسهم الجميع في هذا، الآباء والمؤسسة، والمدرس، وباقي الفاعلين في المنظومة التربوية، والمجتمع، كل واحد يقوم بواجبه المطلوب.
في الأخير يمكن لنا أن نقول بأن فترة المراهقة ليست كباقي المراحل في نمو الإنسان، ولهذا ينبغي دراسة هذه المرحلة دراسة معمقة أكثر، تراعي الزمان والمكان والحال للمراهق، وتأخذه إلى ما ينفعه حالاً ومآلًا.
[1] – تهذيب اللغة. أبواب الغين والشين . ص:45، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.
[2] معجم مقاييس اللغة. باب الشين والغين وما يثلثهما، جزء:3 الصفحة: 196 ، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى:395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ – 1979م، عدد الأجزاء: 6.
[3] النهاية في غريب الحديث والأثر، الصفحة:482 ، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ – 1979م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي، عدد الأجزاء:5.
[4] – القاموس المحيط، فصل الشين، ص:102، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت 817هـ)
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005 م، عدد الصفحات: 1357.
[5] – معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ر ه ق صفحة:951، المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 1424هـ) بمساعدة فريق عمل
الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429هـ – 2008 م، عدد الأجزاء: ٤ (متسلسلة الترقيم) (الأخير فهارس).
[6]– التوقيف على مهمات التعاريف، فصل الراء، ص:95، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت 1031هـ،، الناشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الأولى، 1410هـ-1990م، عدد الصفحات: 393، عدد الأجزاء: 8.
[7]– التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، الجزء:1 ص:447، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)، عني بتَحقيقِه: الدكتور عزة حسن، الناشر: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة: الثانية، 1996 م، عدد الأجزاء:1.
[8] – لسان العرب، فصل القاف، ص:503، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت 711هـ)، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414 هـ عدد الأجزاء: 15.
[9] – نفس المصدر، ص:503.
[10]– مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها. الصفحة:95، مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، المؤلف: على أحمد مدكور، الناشر: دار الفكر العربي، الطبعة: 1421هـ – 2001م، عدد الأجزاء:1.
[11]– مجلة البيان، الجزء:127، الصفحة:30، مجلة البيان، أصدرها: عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سيد بن أحمد البرقوقي الأديب المصري (المتوفى: 1363هـ)، الأعداد: 62 عدد
[12] – منهاج التربية الإسلامية لمحمد قطب، الصفحة:495، المؤلف: محمد بن قطب بن إبراهيم، الناشر: دار الشروق، الطبعة: السادسة عشرة، عدد الأجزاء:2.
[13] – رواه الإمام أحمد في مسنده، رقم: 8417، الباب: مسند أبي هريرة، ج:14.
المصادر والمراجع
1) القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
2) بيئات التربية الإسلامية، المؤلف: عباس محجوب، الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة: السنة الثانية عشر – العدد السادس والأربعون – ربيع الآخر- جمادى الأولى – جمادى الثانية، 1400هـ، عدد الأجزاء:1، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005 م، عدد الأجزاء: 1.
3) التربية الإسلامية للشباب، المؤلف: عبد الرحمن بله علي، الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: ربيع الآخر – رمضان 1401 هـ، عدد الأجزاء: 1.
4) التَّلخِيص في مَعرفَةِ أسمَاءِ الأشياء، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)، عني بتَحقيقِه: الدكتور عزة حسن، الناشر: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة: الثانية، 1996 م، عدد الأجزاء: 1.
5) تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.
6) التوجيه الإسلامي للنمو الإنساني عند طلاب التعليم العالي، المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله الزيد، الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة السابعة والعشرون، العددان (103 – 104) 1416/1417هـ، عدد الأجزاء: 1.
7) التوقيف على مهمات التعاريف، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت 1031هـ،، الناشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الأولى، 1410هـ-1990م، عدد الصفحات: 393، عدد الأجزاء:8.
8) القاموس المحيط، فصل الشين، ص:102، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت 817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.
9) لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت 711هـ)، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1414 هـ عدد الأجزاء: 15.
10) مجلة البيان، أصدرها: عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سيد بن أحمد البرقوقي الأديب المصري (المتوفى: 1363هـ)، الأعداد: 62 عدد.
11) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، المؤلف: الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الناشر: موقع الجامعة على الإنترنت، عدد الأجزاء: 120 عددًا.
12) المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458ه]، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2000 م، عدد الأجزاء: 11 (10مجلد للفهارس.
13) مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م، عدد الأجزاء:1.
14) معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى:395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ – 1979م، عدد الأجزاء: 6.
15) معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ر ه ق صفحة:951، المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤٢٤ هـ) بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429هـ – 2008 م، عدد الأجزاء: ٤ (متسلسلة الترقيم) (الأخير فهارس).
16) مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، المؤلف: على أحمد مدكور، الناشر: دار الفكر العربي، الطبعة: 1421هـ – 2001م، عدد الأجزاء: 1.
17) منهاج التربية الإسلامية بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، العمومي، والخصوصي /2016، مديرية المناهج-المغرب.
18) منهج التربية الإسلامية، المؤلف: محمد بن قطب بن إبراهيم، الناشر: دار الشروق، الطبعة: السادسة عشرة، عدد الأجزاء: 2.
19) النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ – 1979م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي، عدد الأجزاء: 5.

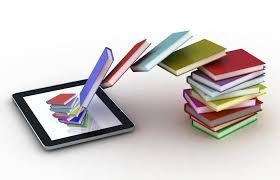
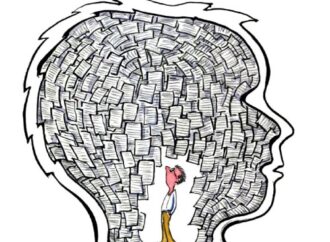

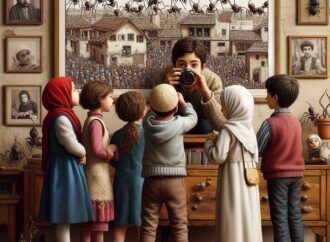
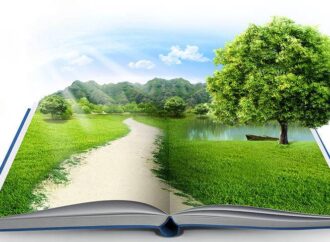






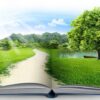

اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *