التنمية وتشكلات الخطاب الأدبي النسائي
محاور البحث:
- مدخل عام.
- أولا : مفهوم الخطاب الأدبي النسائي.
- ثانيا : مفهوم التنمية.
- ثالثا : علاقة الخطاب الأدبي النسائي بالتنمية.
- خاتمة.
مدخل عام:
إن المشكل الأساسي الذي يواجهنا هو مشكل إيديولوجي بشكل أساسي، يتمثل في صعوبة الربط بين المعارف المختلفة والمشارب المتنوعة التي يحتويها الخطاب الأدبي النسائي، – وخاصة في علاقته بمصطلح التنمية -، وما يحمل من أبعاد مجتمعية وثقافية وقانونية وسياسية وتنموية، أي بعبارة موحدة بعده الإيديولوجي المتمثل في الحمولات والمدلولات والإيديولوجيات وحتى الإكراهات والإخفاقات والنجاحات التي يحملها في ذاته.
إن التركيز سيتم في الأساس على معطيات نظرية، متسائلين في نفس الوقت عن ماهية الخطاب بصفة عامة، والخطاب الأدبي النسائي بصفة خاصة، وعن علاقته بالتنمية، وكيف ارتبط بالخطابات الأخرى التي ظهرت… وإلى أي حد تأثر بتلك الخطابات المتعددة.
لقد ظل الخطاب الأدبي النسائي طيلة ما يزيد على قرن من الزمن يطرح بنفس الصورة وبنفس الإشكاليات وحتى بنفس المنهج، وهو ما حال دون تطوره وتقدمه – وهو الشيء نفسه بالنسبة لمفهوم التنمية – أي أننا أصبحنا أمام نفس تكرار للصورة، ليس من طرف الآخر (الرجل)، بل من طرف المرأة ذاتها صاحبة هذا الخطاب، فمجمل الأبحاث والدراسات التي أنجزت في هذا المجال ظلت تكرر نفسها، وكأننا في دائرة مفرغة. صحيح أن هنالك نتائج كثيرة وأبحاث ودراسات لا يستهان بها في هذا المجال، إلا أن ذلك كله لم يسهم في تطوير وتنمية ذلك الخطاب.
وبالرغم من المعارف المختلفة التي تدخل ضمن مجالي التنمية والخطاب الأدبي النسائي، إلا أن آليات ومناهج التحليل التي سنعتمد عليها في دراستنا لن تحمل في طياتها الكثير من المفاهيم والدراسات النظرية، لأن هدفنا ليس هو إثبات تلك النظريات أو نفيها، بل تقديم قراءة لتشكلات الخطاب الأدبي النسائي من خلال مفهوم التنمية، للوصول إلى غاية أو هدف أساسي يتمثل في البحث عن منهج استدلالي علمي، يوافق ويلائم بين الإطار النظري والتطبيقي للموضوع.
إن الهدف الأساسي من البحث هو دراسة الإشكالية النظرية للخطاب الأدبي النسائي وعلاقته بالتنمية في مضمونه وسياقه العام، كشكل من أشكال التفكير المعرفي، وليس في جزئياته، وهذا الخطأ هو ما وقع فيه باحثون ومفكرون كثر، حيث تعرضوا لهذه الإشكالية في جزئياتها الخاصة جزئية جزئية وأفقدوا الإشكالية العامة مضمونها الإيديولوجي والفكري بصورة عامة، فظل ذلك الخطاب تائها خلف إشكاليات فرعية وليس وراء الإشكال الأساسي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي الطريقة أو الطرق التي ستتم بها تلك الدراسة؟ وهل نملك بالفعل من الآليات والوسائل ما يمكننا من القيام بذلك.
إن الرؤية الشمولية للخطاب الأدبي النسائي ولمفهوم التنمية بشكل عام، تطرح أمام الباحث مجموعة من الأسئلة البحثية – بل يمكن القول بأننا بصدد خوض مغامرة كبيرة قد تحمل كثيرا من المخاطر- وإن كان البحث العلمي في حقيقته عبارة عن مغامرات كبيرة.
يجب الاعتراف أولا، بأن إشكال التنمية في منظور الخطاب الأدبي النسائي هو إشكال “سلطة” و”معرفة”، في آن واحد، أي أنه إشكال سيطرة المؤسسات “السلطوية” داخل المجتمع بكل تجلياته وأنماطه المختلفة، وبالتالي فإن الباحث أو الكاتب في هذا المجال يكون دائما محل تهمة، ومتهما في آن واحد.
من الضروري أيضا الإشارة في هذا البحث إلى مسألة جديدة في الرواية والنقد العربيين، تتعلق بالخيال العلمي في ارتباطه بالرواية النسائية بشكل خاص والرواية العربية بشكل عام، وإن كان من الصعب الحديث عن موضوع الرواية العربية في الخيال العلمي بسبب ندرتها -إن لم نقل عدم وجودها- كما أن الموضوع، موضوع حديث في الثقافة العربية والثقافة الإنسانية بشكل عام. هناك أيضا ما يعرف بالأدب العجائبي، الذي يختلف عن أدب الخيال العلمي باعتباره يقوم على السحر والعلاقات غير الطبيعية/ المنطقية، والقوى الخارقة التي جسدتها الإنسانية في أدب الملاحم، الأسطورة، الفنتازي…
ومع ذلك فإنه من حقنا أن نطرح ما يلي:
ما المقصود بالخطاب الأدبي النسائي؟ وهل هو خطاب واحد أو عدة خطابات؟ وهل استطاع بالفعل، التحرر من البعد الإيديولوجي؟ ثم هل تغيرت أشكال وأنماط الخطا بل تتماشى مع الواقع، ولتعبر عن المشكلات الكبرى التي نعيشها اليوم؟ وما هو مفهوم التنمية؟ وأي علاقة تربط بين التنمية والخطاب الأدبي النسائي؟
هذه الأسئلة البحثية ليست وحيدة أو نهائية، كما أننا لا ندعي بأننا أول من طرحها، وبأننا سنجيب عليها جميعا، لكن يبقى الهدف الأساسي منها هو المساهمة قدر الإمكان في البحث عن مقاربة جديدة لتلك الإشكالات المتولدة عن هذا الموضوع، قصد تحليلها والاستفادة منها، من خلال الآليات المنهجية المتوفرة حول الموضوع.
أولا: مفهوم الخطاب الأدبي النسائي.
لقد استعمل مصطلحا “النص والخطاب” في النقاشات الحديثة حول بنية اللغة فيما وراء مستوى الجملة دون تمييز جاد بينهما. وعموماً توجهت النقاشات ذات الأساس أو الهدف الاجتماعي إلى استعمال مصطلح الخطاب (Corsaro، 1980)، في حين اتجهت تلك النقاشات ذات الأساس أو الهدف اللغوي إلى استعمال مصطلح “النص” (Vandijk-1978)، فعندما تكون مادية اللغة وشكلها وبنيتها هي الموضوع يتجه التأكيد ليكون نصا، وحيث يكون محتوى اللغة ووظيفتها ودلالتها الاجتماعية هي الموضوع؛ تتجه الدراسة للخطاب[1].
يعد الخطاب السردي مشروعا منظما وفق الغايات القصوى المقصود بلوغها، حيث يدل على النص المقروء في حقيقته المادية ومن حيث هو نص مكتوب بلغة معفية تستغرق قراءته وقتا معلوما، كما تخضع لترتيب زماني خطي، أما السردية فتحيل على النقيض من ذلك على ضرب معين من القراءة وطريقة خاصة في وصف المادة وتنظيمها، أي إعادة كتابتها انطلاقا من فرضيه مؤداها أن المعنى ليس معطى قبليا، إنما يستخلص من فنون التآلف والاختلاف والتقابل القائمة بين الوحدات التركيبية والتحولات المتتابعة في المحور السياقي[2].
إن مصطلح الخطاب النسائي هو دالّ إلى حدّ كبير على خصوصية ما تكتبه المرأة مقابل ما يكتبه الرجل. وقد شهد المصطلح تجاذبات عدة حول طبيعة التسمية في الساحة الأدبية والنقدية الحديثة؛ وأيا كانت هذه المصطلحات (الأدب النسائي، أو الأنثوي أو أدب المرأة)،فهي لا تخرج في مجملها عن الإشارة إلى ذلك المنجز الذي يصدر عن المرأة على خلفية وعي متقدم، ناضج ومسؤول لجملة العلاقات التي تحكم وتتحكم في شرط المرأة في مجتمعها … تعي كاتبته القضايا الفنية والبنائية واللغوية الحاملة للقدرات التعبيرية المثلى عن حركة التيارات العميقة المولدة للوعي النسائي الجمعي، والوعي الاجتماعي الكلي المحيط به والمشتبك معه في صراع حيّ ومتجدد بالغ الحيوية[3].
ترى ماري إيجلتون Mary Eagliton في تعريفها للأدب النسوي أنه الأدب الذي يسعى للكشف عن الجانب الذاتي الخاصّ بالمرأة، بعيدًا عن تلك الجوانب التي اهتمّ بها الأدبُ لعصور طويلة خلتْ. أيْ أنّ الأدب النسوي هو الذي يعبر بصدق عن الطابع الخاص لتجربة الأنثى في معزل عن المفاهيم التقليدية، وهو – زيادة على ذلك – الأدب الذي يجسد خبراتها في الحياة. وتضيف إلين شوالتر Showalter إلى هذا التعريف تحديدًا آخر يزيد هذا الأدب تعريفًا، فالأدب النسوي – لديها- هو الأدب الذي يكشفُ بوضوح، عن اهتمامات المرأة بذاتها..
أما هيلين سيكسوسCixous فتؤكد، في مقالة لها مشهورة بعنوان “ضحكة الميدوزا” 1993 The Laugh of the Medusa أنَّ الأدب النسوي أدبٌ ذو لغة خاصة به هي لغة الأنثى، التي اكتسبتها منذ الطفولة، فلا يمكن لها – مثلا – أنْ تبحث عن ذاتها، أوْ أْنْ تكشف عن تجربتها الخاصة، وعن أسلوبها الذي يجسد وظيفتها التعبيرية، وعما لديها من جماليات مخبوءة، حتى هذا الزمن، دون هاتيك اللغة[4].
ولا يزال الأدب النسوي مثار جدل في الساحة النقدية العربية بشتى تشكلاته، وبالأخص جنس الرواية التي رافق ظهورها عند المرأة الكاتبة إشكالية الاختلاف والخصوصية في أدب المرأة، والتي كانت تستند في طرحها على الاختلاف الجنسي الذي يترك بصماته الدالة على تميزه وخصوصيته في فعل الكتابة. إلا أن الخطاب النقدي العربي وإلى اليوم لم يصل إلى وضع تصور أو مبحث مستقل للإبداع النسائي مما جعل هذا الأخير وإلى اليوم لا يزال يتخبط في فوضى المفاهيم والمصطلحات ويتأرجح بين إثبات الخصوصية ونفيها عن هذا الأدب.. وفي هذا تغييب لخصوصية ما تبدعه المرأة في مجال الأدب ونفي اختلافه عما يبدعه الرجل فانقسمت الساحة النقدية العربية بخصوص هذه الإشكالية إلى مواقف عدة: بين مقر بتوفر كتابات المرأة على علامات اختلافها وملامح خصوصيتها، ومقر لها بحكم أن الخصوصية في الكتابة الأدبية إّنما مرجعها الفروق الفردية لا الاختلاف الجنسي[5].
ثانيا : مفهوم التنمية.
يعد مفهوم التنمية من المفاهيم الرئيسية التي احتلت مكانا هاما لدي الباحثين، حيث تعددت الدراسات والبحوث والمقلات التي عالجت الإشكالية بمختلف اتجاهاتها النظرية، والتي تنطلق عادة من قضايا مختلفة.ومع منتصف القرن العشرين تحول المفهوم إلى رؤية عامة لدى المجتمعات البشرية، باعتباره وسيلة للرقي والتطور والتقدم، وبالتالي مواجهة التخلف.
وقد عرفت هيئة الأمم المتحدة في عام 1955 التنمية بأنها هي العملية المرسومة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا اعتمادا على إشراك المجتمع المحلي.وفي العام 1956 أعطت تعريفا آخر للتنمية باعتبارها العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع[6].
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم التنميةDéveloppement ظهر بداية في علم الاقتصاد حيث استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر، بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع الحاجات الأساسية عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائدات ذلك الاستغلال.ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين حيث ظهر كحقل منفرد، يهتم بتطوير البلدان غير الأوروبية تجاه الديمقراطية، ولاحقا تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية. فأصبح هناك مفهوم التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوي الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة والمنظمات الأهلية[7].
ومن الناحية الاجتماعية يشير مفهوم التنمية إلى التغير الاجتماعي الذي يتضمن إضافة أفكار جديدة للنظام الاجتماعي بهدف تطوير أحوال الناس.
ثم ظهر مفهوم التنمية البشرية الذي يشمل تنمية الإنسان نفسه باعتباره الهدف والوسيلة والغاية الأولي من التنمية. وهو ما تم الإعلان عنه في برنامج الأمم المتحدة من خلال مفهوم التنمية البشرية، وبذلك أصبح الإنسان هو صانع التنمية وهدفها وذلك ابتداء من العام 1990، معتبرا التنمية البشرية عملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس.
والسؤال المطروح هنا هو: ما هي العلاقة التي تربط مفهوم التنمية بالخطاب الأدبي النسائي؟
ثالثا : علاقة الخطاب الأدبي النسائي بالتنمية.
إن مردودية النظرية بحسب الدكتور سعيد بنكراد، لا تقاس بالكم المصطلحي الهائل المعتمد في التحليل، بل تتجلى في القدرة على اكتشاف بنى وأنساق لم تكن مرئية من خلال القصدية المباشرة للنص.. فالتحليل يمثل دائما وجهة نظر، والتي هي رؤية نسبية، ولا يمثل حقيقة مطلقة[8]، وبالتالي هناك سؤال يتعلق بالعلاقة الثنائية بين مفهوميّ التنمية والخطاب الأدبي النسائي، فهل بالفعل يمكن لنا الآن أن نحدد تلك العلاقة بينهما؟ وإذا قلنا بأن التنمية هي الإنسان، فهل نكون قد حددنا تلك العلاقة كنوع من الإبداع البشري المشترك؟ ونحن هنا لا نود تحديد مفهومي التنمية والخطاب بقدر ما نسعى إلى إبراز تحققهما على مستوى الممارسة النظرية.
ولا شك بأن مختلف الأسئلة المطروحة التي أثارها ويثيرها موضوع العلاقة بين التنمية والخطاب الأدبي النسائي، من شأنها أن تغني الخطاب الأدبي بشكل عام والخطاب النسائي بشكل خاص وتنعكس بالإيجاب على التنمية البشرية بشكل عام.
بين التنمية والخطاب أكثر من وشيجة اتصال وانقطاع أو انفصال، إذ ليس كل خطاب تنمية بالضرورة، ولا كل تنمية يمكن أن تكون قرينة بالخطاب. ومثلما أن هناك تنمية بنيت على المعرفة المسبقة بالأوضاع العامة للمجتمع، وإن تكن نسبية، هناك كذلك خطاب مبني على أدوات معرفية، بكل تفاصيلها السياسة والاجتماعية والفكرية والفلسفية، وبالتالي العيش وسط عالم أبرز سماته التطور واللحاق بسلم الحداثة، لا الاقتصار على التحديث فقط.
يعد الأدب الذي تكتبه المرأة وبهذا الزخم الذي نجده اليوم ظاهرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ليس فِي الوطن العربي حسب، بل وفي العالم بأسره، مما يحيل على أمور جوهرية حافزة خارج العملية الإبداعية أدبا وفنا ونتاجا عاما، أمور تتصل بعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وشيجة مع هذا الإنتاج، فما أن انفتحت أمام المرأة مجالات العلم والعمل والمعرفة حتى وجدنا الكثير من المبدعات اللواتي أكدن قدرات ومهارة فِي الميادين الَّتِي فتحت الأبواب أمامهن مما دفع إِلَى نهوض حقيقة جديدة تدحض ما أشاعه الفكر الذكوري عن قصور المرأة وضعفها وعجز قدراتها عن اللحاق بالرجل، حقيقة تؤكد أن غياب المرأة عن الحضور فِي قلب الحياة كان بسبب ما لحق بها من غبن وقمع فكري وقهر نفسي، وبسبب حجب حقوقها فِي العلم والتدريب على العمل والإسهام فِي دفع عجلة التنمية وإقصائها عن المشاركة فِي صنع القرار[9].
وفي مجال علاقة الخطاب الأدبي النسائي بالتنمية وفي الجانب التطبيقي، نجد الدراسة المميزة التي قامت بها الدكتورة بثينة شعبان بعنوان:100 عام من الرواية النسائية، الرواية النسائية من الهامش إلى المركز، حيث تجادل الكاتبة سؤال الجدارة الفنية للرواية النسائية، خصوصا في بداياتها، رهانا بالريادة والكم، وتستقصي وجود ثلاث عشرة رواية نسائية ظهرت قبل رواية “زينب” لهيكل، تبدأ برواية “حسن العواقب” لزينب فواز المنشورة سنة 1899. وعلى ذلك تحاول قراءة النص الروائي النسوي برافعة تأويلية، لرد تصورات النقاد الذين يعتبرون هذا الفن النسوي غير ناضج وتصعب معايرته، حيث تعترض على تهميش الكتابة النسوية وترد الاعتبار إلى ريادتهن وتجدهن أو توجدهن في الأعمال التي تبتعد عن ثيمة الحب والمراوحة في حيز الرجل إلى رواية الحقوق والحرب والاضطلاع بآمال الأمة (وبالتالي الانشغال دائما بموضوع التنمية)، فبتصورها أن الروائيات العربيات لا يتمتعن برؤية ثاقبة وحسب بل يختلفن أيضا عن الأنظمة الاجتماعية والسياسية الحالية، وبالتالي لا ينبغي عند قراءتها – أي الرواية العربية النسائية – أن تخضع لمحاكمة نفسية للروائية ذاتها. كما تشير الكاتبة إلى أن الروائيات العربيات في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات أدركن عمق علاّت مجتمعاتهن كما بدا في رواية زينب محمد “أسرار وصيفة ” التي تعكس أدوار النساء والرجال، تماما كما كتبت هند سلامة روايتها “الحجاب المهتوك”، أو كما كتبت فتحية محمود الباتع روايتها “مذكرات زائفة” باعتبار أنها رواية واقعية اجتماعية، وكذلك” أيام معه” لكوليت الخوري التي يمكن قراءتها من وجهة المرأة وكبريائها قبالة الرجل والمجتمع، وأيضا سعاد زهير بروايتها “اعترافات امرأة مسترجلة “حيث المناداة بمساواة الجنسين.
إذا، لم يكن الرجل هو الحيز الذي تتحرك فيه الرواية النسائية، أو هذا ما تدلل عليه الدكتورة بثينة شعبان فحتى الحروب تورطت فيها الرواية النسائية، حيث تشير في “روايات الحرب النسائية” إلى أن الحرب ليس هو الميدان الذكوري الذي لا يمكن اقتحامه، فالرواية النسائية العربية لم تتسلل إلى هذا المكمن الذكوري وحسب، بل قلبت معادلته فحين أصر الرجل على عنونة نتيجة حرب حزيران بمسمى “النكسة” أسمتها النساء “هزيمة” كما جادلت ذلك ليلى عسيران في روايتها “عصافير الفجر”. أما في رواية “دمشق يا بسمة الحزن” فقد جسدت ألفة الإدلبي حال ومآل سورية تحت الانتداب الفرنسي، تماما كما تحدثت فتحية محمود الباتع في روايتها “وداع مع الأصيل” عن حقها في الأرض بعناد وتحد، وعن أداء النساء في حالة الحرب والأزمة الوطنية، مثلها مثل بلقيس حوماني في روايتها “سأمر على الأحزان” التي تتحدث عن مقاومة الاحتلال، وكذلك في رواية “تشرق غربا” لليلى الأطرش حيث الإحاطة بتقسيم فلسطين ومتوالية الحروب العربية، وصولا الى رواية “ليلة المليار” لغادة السمان التي جسدت ويلات الحرب الأهلية اللبنانية وعن جرح الذات على خلفية هذه الحرب.
وهكذا تصل ببحثها إلى مرحلة “التجليات” لتؤكد على أن حميدة نعنع وحنان الشيخ وهدى بركات وأملي نصرالله وأحلام مستغانمي يشكلن بداية جديدة في تاريخ الرواية النسائية العربية خصوصا بعد أن خضعت سلسلة من رواياتهن للترجمات فرواية “الوطن في العينين” لحميدة نعنع تتفوق في اختيار اللغة كمكمل للعملية السياسية، وتؤكد على أن النساء لديهن شيء هام يقلنه حتى في المجال السياسي. وفي “حكاية زهرة” لحنان الشيخ تعبير عن النسيج البالي للحياة السياسية والاجتماعية من خلال حياة امرأة في ظل الحرب حيث العلاقة السرية مع قناص. أما هدى بركات فتقدم في “حجر الضحك” لاعب الحرب الأهلية من وجهة أخرى حيث التشويه النفسي للذات وحيث الموت والحرب هما الشغل الشاغل اليومي للذين يتعلمون فن التحول إلى تجار للدم. وفي “شجرة الدفلى” تحلل أملي نصرالله التفاصيل الدقيقة لحياة الناس في القرية بكل مظاهرها المكشوفة وتقاليدها السرية، من خلال مشكلة امرأة عربية غير متزوجة كان عليها أن تعيش وتقوم بدورها دون حماية الرجل الاجتماعية.
وبموجب تلك النجاحات الروائية اكتسبت النساء العربيات ثقة فيما يكتبن فاتجهن بتصورها في “سيدات المهنة ” للتنقيب عميقا في الماضي ونشر رؤاهن الخاصة عن تاريخهن الوطني فالمغربية ليلى أبو زيد تعود لتكتب بالعربية “عام الفيل” كأول روائية مغربية تقدم دليلا روائيا على ارتباطها بأصلها واعتزازها به، وكذلك أحلام مستغانمي كأول جزائرية تكتب بالعربية، حيث تعيد في “ذاكرة الجسد” بناء تاريخ الثورة الجزائرية، كما تؤكد عالية ممدوح في “حبات النفتالين” على محاولة لحفظ قصص الأعظمية باستخدام الحوار باللهجة الدارجة لتمكين القصص المؤثرة. أما سميرة المانع فتسرد في روايتها “حبل السرة ” مراجعة لتاريخ العراق العنيف والبحث عن بذور الصراع في أهم زواياه المهملة، تماما كما حاولت ناديا خوست في روايتها “حب في بلاد الشام” أن تعيد إلى السوريين ذاكرتهم الوطنية. وفي ثلاثيتها “غرناطة ومريمة والرحيل” تخوض رضوى عاشور في إحدى أصعب الفترات السياسية وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ العرب، وكذلك ليلى العثمان في روايتها “المرأة والقطة” حيث تشير إلى المشاكل الاجتماعية التي تعانيها المجتمعات العربية وبصورة خاصة في الخليج، وكذلك هاديا سعيد في “بستان أسود” وأيضا عروسية النالوتي في روايتها “مراتيج” حيث تغوص في عمق الجرح العربي وتسبر الخيبات والنكبات والعادات والتقاليد. أما نوال السعداوي فستتذكرها الأجيال بأنها الكاتبة التحررية التي صرخت صرخة عميقة ومؤثرة في النصف الثاني من القرن العشرين لتحرير المرأة من أغلال الجنس والجسد والتخلف والظلم[10].
وفي مجال تشكلات الخطاب الأدبي النسائي وفي علاقته بالتنمية نجد نموذج رواية الخيال العلمي، كقضية جديدة بالنسبة للخطاب الأدبي النسائي والخطاب الأدبي العربي بصورة عامة.
وبالرغم من حداثة الخيال العلمي، فقد تمكن من خلق تراكم كمي لا يستهان به، حيث يعد ظهور كتاب أمثال الكاتب الفرنسي جيل فيرن Jules Verne الذي يعد من الراوة المؤسسين للخيال العلمي بما خلفه من أعمال تحول بعضها لأفلام ناجحة منها: «خمسة أسابيع في منطاد» في سنة (1863)، «رحلة إلى جوف الأرض» سنة (1864). وبعده انتشر الخيال العلمي في عدد من الدول الأوربية فلمع في انجلترا اسم هربرت جورج ويلز H.G.Wells الذي كتب أول رواياته في الخيال العلمي «آلة الزمن» (The Time Machine) عام 1895 التي تعد من أعظم روايات الخيال العلمي، ليعقبها برواية «حرب العوالم» (The War of the Worlds )سنة 1898.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية سيجد الخيال العلمي التربة الخصبة، وسيخطو به إسحاق عظيموفIsaac Asimov خطوات رائدة لمعرفته الدقيقة بالعلوم ولخياله الواسع وجمعه بين ثقافة الشرق والغرب. وبالتدريج أضحى الخيال العلمي يفرض نفسه على النماذج الأدبية، بعدما أصبح له جمهور متعطش في كل بقاع العالم للمغامرة، وبعد أن استفاد من الثورة الرقمية، والتطور العلمي، التكنولوجي والسينمائي…
أما بالنسبة للعالم العربي فإن كتاب هذا النوع الأدبي لا زالوا على رؤوس الأصابع عربيا، بل من القراء العرب من يعتقد بأنه لا وجود لمثل هذه الكتابات عندنا. والحق أنه بعد التنقيب تم الوقوف على أسماء جد معدودة لها كتابات في الموضوع – وإن كان بعض الباحثين يذهبون إلى اعتبار نص (حي بن يقظان) لابن طفيل، ورسالة الغفران للمعري، ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد ضربا من الخيال العلمي ما دام فيها رحلة إلى عوالم غريبة- من تلك الأسماء نكتفي بالإشارة إلى نهاد شريف، ومن مؤلفاته: رواية (قاهر الزمن)، (الشيء)، (الذي تحدى الإعصار)، (تحت المجهر)، (بالإجماع)… ومن سوريا اشتهر طالب عمران الذي أثرى الخزانة العربية بأزيد من سبعين رواية وقصة في الخيال العلمي أهمها: ضوء في الدائرة المعتمة1980 أسرار من مدينة الحكمة 1988،مساحات للظلمة 1992. كما يعد الكاتب المصري نبيل فاروق من أشهر الكتاب العرب في روايات الخيال العلمي، من مؤلفاته : “ملف المستقبل”، “رجل المستحيل”،” كوكتيل 2000″ ، رواية “ظل الأرض”، “شمس منتصف الليل”، رواية “صرع”…[11].
أما بالنسبة لمجال أدب الخيال العلمي النسائي فلا نستطيع أن نتجاهل بعض التجارب في هذا المجال- وإن كانت قلية جدا_ مثل روايات الكاتبة الكويتية طيبة الابراهيم التي تعد أول من كتب الخيال العلمي في الكويت، وكتابات أخرى مثل تجربة المصرية صفاء النجار[12].
لكن هذه التجارب الحديثة وغيرها التي بدأت في القرن الماضي لا تشكل في مجملها حركة ذات ملامح واضحة، كما لا يوجد أيضا حركة نقدية عربية ترافق هذا النوع من الكتابة، إضافة لعدم الإقبال عليه من القراء المعجبين بأدب الخيال العلمي والذين يجدون ضالتهم في الكتب المترجمة والأفلام السينمائية[13].
هناك أيضا ما يعرف بالخطابات الروائية العجائبية، والتي هي عبارة عن نصوص تخييلية تتراوح بين العجيب والغريب، وبين الوهم والواقع، وبين المنطق واللامعقول، وبين الانسجام واللانسجام، وتعتمد أحداثا غريبة ومدهشة تحدث التردد الذي يطال الشخصية الرئيسة في القصة أو الرواية أو أي شخصية أخرى من شخصياتها. كما يشمل القارئ الذي يقف حائرا أمام غموض الأحداث وغرابتها ويحاول أن يجد لها تفسيرا طبيعيا أو غير طبيعي، وهذا التفسير هو الذي ينهي ظاهرة الغرابة ويخرج النص من الفانتاستيك[14].
خاتمة
يتبين من خلال ما سبق مدى أهمية السياق التاريخي والاجتماعي والثقافي المحيط بعلاقة التنمية بالخطاب الأدبي النسائي، إنتاجا وتلقيا. فالسياق، بمفهومه الواسع، لا ينحصر فقط في الظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية التي أنتج فيها الخطاب، بل يعني أيضا الظروف المحيطة بتلقي هذا الخطاب. فالبحث في هذه الظروف لا يمكن إلا أن يعين على فهم أحسن للعلاقات التي تربط بين التنمية وذلك الخطاب، وبالتالي يمكننا من فهم أحسن للخطاب اعتمادا على تشكلات الخطاب المتعددة والتي تتحقق فيها ومن خلالها هذه العلاقة.
لقد انشغل الخطاب النسائي، والخطاب بصورة عامة، وبكل أنواعه المختلفة، وخاصة الأدبي والاجتماعي، بإشكالية التنمية، متسلحا في ذلك بمدارس متنوعة وبمناهج فكرية متعددة، انتهت به إلى إعادة النظر في المعالجة النظرية والأدوات والإجراءات المتعلقة بالموضوع، وظهر في جل تلك الدراسات بأن مفهوم التنمية يشتمل على كثافة وعلى حمولات يصعب نقلها مباشرة بسبب التيارات والاتجاهات المختلفة التي عالجت المفهوم.
وبالجملة فإن دراسة مفهوم التنمية من خلال الخطاب الأدبي النسائي يكشف عن عالم كبير، عالم متغير، صحيح أن هناك متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى ثقافية تؤثر في تلك الدراسة، وتحول دون تحقيق أهدافها العامة. كما أن التعامل النقدي والإعلامي مع الموضوع لا يزال ينظر إليه على أساس أنه عمل شخصي، أي أنه إنتاج شخص (المرأة)، وليس على أساس إبداعي يفرض نفسه كقيمة جمالية، وإنسانية، وإبداعية.
هناك سؤال جهوري يتعلق بتطور الخطاب الأدبي النسوي بشكل خاص، والخطاب الأدبي بشكل عام، هل هو مرتبط بفشل مسارات التنمية وتطورها؟
وفي الختام فإن هذه الدراسة كانت تروم في الأساس إلى إظهار الجانب المحجوب والمخفي من العلاقة التي تربط ذلك الخطاب بالتنمية، عن طريق البحث داخل عناصره الداخلية وكذا في واقع الممارسة الخطابية، ليس كإبداع فردي فقط بل كإبداع إنساني، بغية الوصول إلى مقاربة جديدة تؤسس لفكر جديد، فكر تنموي يؤسس لمرحلة جديدة من التعايش بين مختلف مكونات المجتمع الواحد.
قائمة المصادر والمراجع:
- د. جميل حمداوي، الرواية العربــية الفانتاستيكية، مقال ضمن مجلة ندوة الإلكترونية، //arabicnadwah.com/articles/fantasia-hama https
- د. عباس عبد الحليم عباس، “في الرواية النسويّة العربية” كتاب يسلط الضوء على الخطاب النسْويّ، صحيفة قاب قوسين الالكترونية الثقافية، بتاريخ: 06/23/2012، http://www.qabaqaosayn.com/content
- الدكتور سعيد بنكراد بعنوان: تعقيب على بحث عبد الله إبراهيم: ” الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية”، ضمن أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر بعنوان: الرواية العربية.. ممكنات السرد، 11-13 ديسمبر 2004، مرفق العدد 357 من سلسلة عالم المعرفة، الجزء الثاني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، 2008.
- الدكتور سعيد بنكراد بعنوان: تعقيب على بحث عبد الله إبراهيم: ” الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية”، ضمن أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر بعنوان: الرواية العربية.. ممكنات السرد، 11-13 ديسمبر 2004، مرفق العدد 357 من سلسلة عالم المعرفة، الجزء الثاني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، 2008.
- رواية الخيال العلمي العربية.. جني على طبق طائر، مقال منشور ضمن موقع ميدل إيستاولاين الإلكتروني https://middle-east-online.com
- سعيدة بنبوزة، الهوية والاختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في الأدب العربي الحديث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر – باتنة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السنة الجامعية 2007-2008.
- غونتر كريس، البني الإيديولوجية في الخطاب، ترجمة عال الثامري، مجلة علامات، العدد 28، مكناس، المملكة المغربية، 2007.
- الكبير الداديسي، الخيال العلمي والرواية العربية، موقع ديوان العرب : منبر حر للثقافة والفكر والأدب، الأحد 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2017،
https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=47950
- محمد العباس بعنوان : قراءة في 100 عام من الرواية النسائية لبثينة شعبان، الرواية النسائية من الهامش إلى المركز، صحيفة اليوم الالكترونية السعودية، بتاريخ: الاثنين الموافق 16 فبراير 2004 العدد : 11203
- محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي، نظرية كريماس، مساءلات، الدار العربية للكتاب، بدون مكان للنشر، 1993.
- محمد شفيق، التنمية الاجتماعية: دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، بدون سنة نشر.
- نازك الاعرجي، صوت الأنثى، (دراسات في الكتابة النسوية العربية)، الأهالي للطباعة والنشر1997، دمشق ط1.
- نصر عارف، في مفاهيم التنمية ومصطلحاتها، مجلة ديوان العرب، عدد حزيران 2008، القاهرة.
[1] – غونتر كريس، البني الإيديولوجية في الخطاب، ترجمة عال الثامري، مجلة علامات، العدد 28، مكناس، المملكة المغربية، 2007، ص136.
[2]– محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي، نظرية كريماس، مساءلات، الدار العربية للكتاب، بدون مكان للنشر،1993، ص 35-71.
[3]– نازك الاعرجي، صوت الأنثى، (دراسات في الكتابة النسوية العربية)، الأهالي للطباعة والنشر1997، دمشق ط1، ص24
[4]– د. عباس عبد الحليم عباس، “في الرواية النسويّة العربية” كتاب يسلط الضوء على الخطاب النسْويّ، صحيفة قاب قوسين الالكترونية الثقافية، بتاريخ: 06/23/2012 ، http://www.qabaqaosayn.com/content
[5] – سعيدة بنبوزة، الهوية والاختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في الأدب العربي الحديث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر–باتنة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السنة الجامعية 2007-2008،، ص: 63.
[6]– محمد شفيق، التنمية الاجتماعية: دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، بدون سنة نشر، ص13.
[7]– نصر عارف، في مفاهيم التنمية ومصطلحاتها، مجلة ديوان العرب، عدد حزيران 2008، القاهرة، ص2-3.
[8]– أنظر في هذا الصدد دراسة للدكتور سعيد بنكراد بعنوان: تعقيب على بحث عبد الله إبراهيم: ” الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية”، ضمن أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر بعنوان: الرواية العربية.. ممكنات السرد، 11-13 ديسمبر 2004، مرفق العدد 357 من سلسلة عالم المعرفة، الجزء الثاني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، 2008.
[9]– أنظر في هذا الصدد دراسة ل ريتا عوض بعنوان: النظرة الجنسية إِلَى الأدب، 72، مجلة العربي، ع. 541، 2003.
[10]– أنظر في هذا الصدد دراسة ل : محمد العباس بعنوان: قراءة في 100 عام من الرواية النسائية لبثينة شعبان، الرواية النسائية من الهامش إلى المركز، صحيفة اليوم الالكترونية السعودية ، بتاريخ : الاثنين الموافق 16 فبراير 2004 العدد : 11203
[11]– الكبير الداديسي، الخيال العلمي والرواية العربية، موقع ديوان العرب : منبر حر للثقافة والفكر والأدب، الأحد 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=47950
[12]– رواية الخيال العلمي العربية.. جني على طبق طائر، مقال منشور ضمن موقع ميدل إيست اولاين الإلكتروني https://middle-east-online.com
[13]– نفس المرجع السابق.
[14]– د. جميل حمداوي، الرواية العربــية الفانتاستيكية، مقال ضمن مجلة ندوة الإلكترونية،
//www.arabicnadwah.com/articles/fantasia-hamahttps://



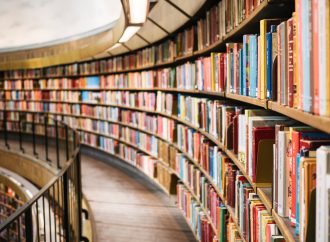
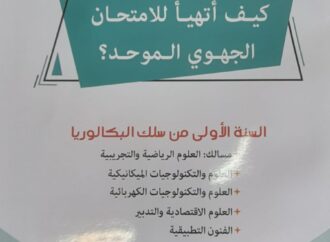
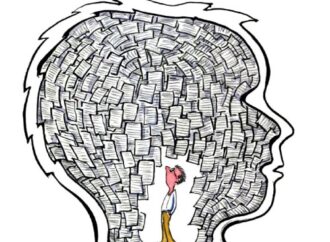







اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *