دلالة الأمر في القرآن الكريم hgùوأثرها في اختلاف الفقهاء
- بوسلهام هرو– جامعة ابن طفيل – القنيطرة -(مختبر علوم الأديان ) – المغرب
- د:محمد بنكيران – جامعة ابن طفيل (مختبر علوم الأديان) – القنيطرة – المغرب
مقدمة
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن كتاب الله هو أساس الحياة الإيمانية، وبتوجيهاته وإرشاداته نسير نحو المنهج الصحيح، الذي لا يزيغ صاحبه، وبالعمل به واتباع سبيله نُحجب عن الشقاء العاجل والآجل، ونعيش السعادة الدائمة، التي هي مقصد من مقاصد نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:[طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى](سورة طه، الآية:1-2).
وكتاب الله لا تنقضي عجائبه، والباحث فيه مهما بذل الجهد وأعطى كل ما لديه لا يمكنه أن يحيط بمراد الله المطلق والنهائي من كتابه، ولكن كل واحد يأخذ بقدر استعداده وإمكانياته، وما حصل عليه من أدوات علمية تساعده على الخوض في بحر معانيه، والقطف من ثماره.
هذا وقد ذكر العلماء للخلاف الفقهي أسباباً كثيرة، وكان من أهمها الدلالة اللغوية للكلمات، وذلك مثل المنطوق والمفهوم، والأمر والنهي وغيرها من المباحث اللغوية الأصولية، وهذه المباحث توجد في الوحيين معاً، وقد اقتصرت على الأمر في القرآن الكريم المختلف في دلالته.
إشكالية البحث:
هل الأمر في القرآن الكريم يكون دائماً على سبيل الحتم واللزوم؟ أو أن دلالته تحتمل غير ذلك؟.
ولمقاربة هذه الإشكالية والإجابة عنها قسمت بحثي إلى مقدمة ومدخل وثلاثة مباحث وخاتمة، تكلمت في المدخل عن بعض المسائل التي تناولها الأصوليون في الأمر، وفي المباحث على مجموعة من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء بسبب دلالة الأمر في القرآن الكريم، وفي كل مبحث أذكر المسألة الفقهية والآية التي ورد فيها الأمر، وأذكر في كل مبحث ثلاثة فروع، وأتناول في الفرع الأول المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية، وفي الفرع الثاني الدلالة الأصولية للأمر، وأما الفرع الثالث فأذكر فيه خلاصة القول في المسألة الفقهية.
وليس هدفي الأول في هذا البحث أن أبين القول الراجح من المرجوح في المسائل الفقهية، أو القول المشهور في مذهب ما، بل غرضي الأسمى هو أن أبين كيف بني الاختلاف في المسائل الفقهية بسبب دلالة الأمر.
المدخل: مسائل تحدث عنها الأصوليون في الأمر:
– هل الأمر المطلق يقتضي الوجوب؟
تباينت أقوال العلماء في دلالة الأمر بين الوجوب والندب والتوقف في حالة إطلاقه، إلا أن أكثرهم قالوا بالوجوب، ولهذا قال الزركشي: «إن ظاهر مذهب الشافعي أن الأمر بمجرده على الوجوب إلى أن يدل دليل على خلافه، وهو قول أكثر أصحابنا منهم أبو العباس وأبو سعيد وابن خيران وغيرهم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء».([1])
وقال الشيرازي[2] في التبصرة: «إِذا تجردت صيغَة الْأَمر اقْتَضَت الْوُجُوب وقالت الأشعرية إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فيها، ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل، وقالت المعتزلة يقتضي الأمر الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل، وهو قول بعض أصحابنا
لنا قوله عز وجل {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف:12]فوبخ الله تعالى إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر، فدل على أنه يقتضي الوجوب، فإن قيل يجوز أن يكون الأمر الذي وبخه على مخالفته قارنته قرينة تقتضي الوجوب فخالف ذلك فلهذا استحق الذم والتوبيخ، والجواب أن الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد الأمر من غير قرينة، ألا تراه قال {إذ أمرتك} ولم يذكر قرينة فمن ادعى انضمام قرينة إلى الأمر فقد خالف الظاهر، وجواب آخر وهو أن الله سبحانه ذكر الأمر في موضع آخر فقال {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس}[البقرة:34] وليس معه قرينة فالظاهر أنه وبخه على مخالفته هذا الأمر».([3])
وإذا تتبعنا الأوامر الواردة في القرآن الكريم نجد أن جلها يدل على الوجوب، إلا نماذج قليلة، وبعضها مختلف في دلالتها بين الوجوب وغيره، وهو موضوع بحثنا.
– هل الأمر المجرد عن القرائن يقتضي التكرار ؟
هذه من المسائل المختلف فيها بين الأصوليين، ولهذا قال الجصاص[4] في كتابه الفصول في الأصول: «اختلف الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا؟ فقال أكثر الفقهاء: لا يجب التكرار إلا بدلالة، ومتى فعل المأمور به مرة واحدة فقد قضى عهدة الأمر. قال أبو بكر – رحمه الله -: والذي يدل عليه مذهب أصحابنا – رحمهم الله -: أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها، إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى تقوم الدلالة على إرادة أكثر منها لأن الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة”.
ثم مثل الإمام الجصاص لهذا الاختيار بمثالين فقال: «والذي يدل على ذلك من مذهب أصحابنا قولهم فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك أن هذا على واحدة إلا أن يريد ثلاثا فيكون ثلاثا، وقولهم فيمن قال لعبده: تزوج أنه على امرأة واحدة إلا أن يريد ثنتين فيكون (الأمر) على ما عنى، فهذا يقتضي أن يكون مذهبهم في الأمر إذا لم يتعلق بعدد مذكور في اللفظ أنه يتناول مرة واحدة (ويحتمل أكثر منها إلا أنه لا يحمل على الأكثر إلا بدلالة). وقال بعضهم: يقتضي التكرار إلا أن تقوم الدلالة على غيره”.
وقد استدل لهذا الرأي فقال: «الدليل على صحة القول (الأول) أنه متى فعل المأمور به مرة واحدة فقد تناوله إطلاق الوصف بأنه قد فعل ما أمر به، ولا يقول أحد أنه فعل بعض المأمور به وإن كان يقتضي التكرار لما جاز أن يقال: إنه قد فعل ما أمر به».([5])
وقال الشيرازي في اللمع: «إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز، وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن أصحابنا من قال: يجب تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال: لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح».([6])
-هل الأمر يقتضي الفور والمبادرة؟
هذه المسألة الأصولية لها ارتباط وكيد بمسألة الأمر يقتضي التكرار أم لا، وليس فيها قول واحد للعلماء، ولهذا يقول الإمام الغزالي مبيناً أقوال العلماء في القاعدة الأصولية: “الأمر يقتضي الفور عند قوم، ولا يقتضيه عند قوم، وتوقف فيه من الواقفية قوم. ثم منهم من قال: التوقف في المؤخر هل هو ممتثل أم لا، أما المبادر فممتثل قطعا، ومنهم من غلا وقال: يتوقف في المبادر أيضا.، والمختار أنه لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه البدار، والتأخير، ويدل على بطلان الوقف أولا فنقول للمتوقف: المبادر ممتثل أم لا؟ فإن توقفت فقد خالفت إجماع الأمة قبلك، فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغ في الطاعة مستوجب جميل الثناء، والمأمور إذا قيل له: قم يعلم نفسه ممتثلا، ولا يعد به مخطئا باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع؛ وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال عز من قائل: {سارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران: 133] وقال: {يسارعون في الخيرات، وهم لها سابقون} [المؤمنون: 61]، وإذا بطل هذا التوقف فنقول: لا معنى للتوقف في المؤخر لأن قوله: ” اغسل هذا الثوب ” مثلا لا يقتضي إلا طلب الغسل، والزمان من ضرورة الغسل كالمكان، وكالشخص في القتل، والضرب، والسوط، والسيف في الضرب، ثم لا يقتضي الأمر بالضرب مضروبا مخصوصا، ولا سوطا، ولا مكانا للأمر، فكذلك الزمان؛ لأن اللافظ ساكت عن التعرض للزمان، والمكان فهما سيان، ويعتضد هذا بطريق ضرب المثال لا بطريق القياس بصدق الوعد إذا قال: ” اغسل، واقتل ” فإنه صادق بادر أو أخر، ولو حلف: لأدخلن الدار لم يلزمه البدار.
وتحقيقه أن مدعي الفور متحكم، وهو محتاج إلى أن ينقل عن أهل اللغة أن قولهم: افعل للبدار، ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواترا، ولا آحادا».([7])
يظهر من خلال ما سبق ذكره من أقوال العلماء أن مباحث الأمر ليس فيها قول واحد، وهذا الاختلاف يترتب عليه اختلاف في الفروع الفقهية، وهذا ما سنراه في المباحث التطبيقية التي سنعرضها.
المبحث الأول: سجود التلاوة
قال الله تعالى: {إِذا تتلى عليهم ءاية الرحمن خروا سجداً وبكياً}(مريم، الآية:58)
الفرع الأول: معنى خروا وسجدا في الآية
السجود منه ما هو اختياري، ومنه ما هو سجود تسخير، إلا أن الأول خاص بالإنسان، والثاني عام يشمل الإنسان وغيره، وقد ذكر الراغب الأصفهاني[8] هذا مفصلاً فقال: «السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوانات والجمادات، وذلك ضربان، سجود باختيار، وليس ذلك إلا للإنسان، وبه يستحق الثواب، نحو قوله: “فاسجدوا لله واعبدوا” [النجم/ 62]، أي: تذللوا له، وسجود تسخير، وهو للإنسان، والحيوانات، والنبات، وعلى ذلك قوله: “ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال” [الرعد: 15]، وقوله: “يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله” [النحل/ 48]، فهذا سجود تسخير، وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة، وأنها خلق فاعل حكيم، وقوله: “ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون” [النحل/ 49] ، ينطوي على النوعين من السجود، التسخير والاختيار، وقوله: “والنجم والشجر يسجدان” [الرحمن/ 6]، فذلك على سبيل التسخير، وقوله: اسجدوا لآدم [البقرة/ 34]، قيل: أمروا بأن يتخذوه قبلة، وقيل: أمروا بالتذلل له، والقيام بمصالحه، ومصالح أولاده، فائتمروا إلا إبليس، وقوله: “ادخلوا الباب سجداً” [النساء/154]، أي: متذللين منقادين، وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة، وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن، وسجود لشكر، وقد يعبر به عن الصلاة بقوله: “وأدبار السجود” [ق/ 40]، أ ي:أدبار الصلاة، ويسمون صلاة الضحى: سبحة الضحى، وسجود الضحى، “وسبح بحمد ربك [طه/ 130] قيل: أريد به الصلاة ، المسجد: موضع الصلاة اعتبارا بالسجود، وقوله: “وأن المساجد لله” [الجن/18] قيل: عني به الأرض، إذ قد جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، كما روي في الخبر، وقيل: المساجد: مواضع السجود: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان، وقوله: “ألا يسجدوا لله” [النمل/25] أي: يا قوم اسجدوا، وقوله: “وخروا له سجدا” [يوسف/ 100]، أي: متذللين، وقيل: كان السجود على سبيل الخدمة في ذلك الوقت سائغا».([9])
خر، يقول الراغب خر «فمعنى خر سقط سقوطا يسمع منه خرير، والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو. وقوله تعالى: “خروا له سجدا” فاستعمال الخر تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح، وقوله من بعده وسبحوا بحمد ربهم، فتنبيه أن ذلك الخرير كان تسبيحا بحمد الله لا بشيء آخر».([10])
الفرع الثاني: دلالة الأمر في الآية الكريمة
اختلف العلماء في دلالة الأمر الوارد في الآية بين الوجوب والندب، ولذا قال الجصاص[11]: «فيه الدلالة على أن سامع السجدة وتاليها سواء في حكمها وأنهم جميعا يسجدون لأنه مدح السامعين لها إذا سجدوا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا سجدة يوم الجمعة على المنبر فنزل وسجدها وسجد المسلمون معه، وروى عطية عن ابن عمر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب قالوا السجدة على من سمع وروى أبو إسحاق عن سليمان بن حنظلة الشيباني قال قرأت عند ابن مسعود سجدة فقال إنما السجدة على من جلس لها وروى سعيد بن المسيب عن عثمان مثله قال أبو بكر قد أوجبا السجدة على من جلس لها ولا فرق بين أن يجلس للسجدة بعد أن يكون قد سمعها إذ كان السبب الموجب لها هو السماع ثم لا يختلف حكمها في الوجوب بالنية، وفي هذه الآية دلالة أيضا على أن البكاء في الصلاة من خوف الله لا يفسدها».([12])
وذكر ابن العربي اختلاف مذاهب العلماء في سجود التلاوة فقال: «اختلف الناس في سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعي: ليس بواجب.
وقال أبو حنيفة: هو واجب، وهي مسألة مشكلة عول فيها أبو حنيفة على أن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة»
والأمر على الوجوب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها إذا قرأها. وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت أن عمر قرأ سجدة وهو على المنبر، فنزل فسجد، فسجد الناس معه. ثم قرأ بها في الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء. وذلك بحضرة الصحابة أجمعين من المهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك عليه أحد، فثبت الإجماع به في ذلك؛ ولهذا حملنا جميع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على الندب والترغيب.
وقوله صلى الله عليه وسلم : «أمر ابن آدم بالسجود، فسجد فله الجنة». إخبار عن السجود الواجب؛ ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب».([13])
يقول ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد مبيناً اختيارات العلماء في دلالة الأمر في الآية: “هل هي محمولة على الوجوب، أو على الندب: فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهمهم الأوامر الشرعية، وذلك أنه لما ثبت: أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة، فنزل وسجد، وسجد الناس معه فلما كان يوم الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، قالوا: وهذه بمحضر الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف، وهم أفهم بمغزى الشرع، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة.
وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال: “كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد”.
وكذلك أيضا يحتج هؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام: “أنه لم يسجد في المفصل”. وبما روي: “أنه سجد فيها”. لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى، من قال: إنه سجد، ومن قال إنه لم يسجد.
وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب، أو الأخبار التي تنزل منزلة الأوامر.
وقال أبو المعالي: إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة – أعني: قراءة آية السجود – قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة، وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود.
ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر، وذلك في أكثر المواضع، وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة – أعني: عند التلاوة -، وورد به الأمر مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر، وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها أعني: أنه عند التلاوة، فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه»[14].
الفرع الثالث: حكم سجود التلاوة للتالي والمستمع
اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة بين الوجوب وغيره: فمالك والشافعي يقولان بعدم الوجوب، وأبو حنيفة أوجب السجود، وذلك من خلال الأوامر الشرعية الواردة في ذلك، وكذلك الأخبار المقصود بها الأمر، وهذا ما مال إليه الجصاص في تفسيره.
المبحث الثاني: الاستماع للقرآن الكريم
قال الله تعالى:{وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا} (الأعراف:204)
الفرع الأول: معنى الاستماع والإنصات.
الاستماع، قال فيروز أبادي في القاموس المحيط: «استمع له وإليه: أصغى».([15])
وقال في الإنصات: «نصت ينصت، وأنصت وانتصت: سكت، والاسم: النصتة، بالضم. وأنصته،
وله: سكت (له) واستمع لحديثه. وأنصته: أسكته، و. للهْو: مال. واسْتَنْصتَه: طالَب أن ينصت»([16])
الفرع الثاني: دلالة الأمرين في الآية الكريمة
تباينت أراء العلماء في محمل الأمرين في الآية، فمنهم من قال إن السامع لكتاب الله كلما سمع القرءان يتلى يجب عليه الاستماع والإنصات، ومن العلماء من يرى أن الأمر في الآية محمول على الندب، ولقد حكى الطاهر ابن عاشور[17] أقوال العلماء في المسألة فقال: «وقد اتفق علماء الأمة على أن ظاهر الآية بمجرده في صور كثيرة مؤول، فلا يقول أحد منهم بأنه يجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع وينصت، إذ قد يكون القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته، فلو وجب عليه الاستماع لأمر بترك عمله، ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها:
فمنهم من خصها بسبب رأوا أنه سبب نزولها، فرووا عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الإمام في الجهر، وروى بعضهم أن رجلا من الأنصار صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهرية فكان يقرأ في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فنزلت هذه الآية في أمر الناس بالاستماع لقراءة الإمام. وهؤلاء قصروا أمر الاستماع على قراءة خاصة دل عليها سبب النزول عندهم، على نحو يقرب من تخصيص العام بخصوص سببه، عند من يخصص به، وهذا تأويل ضعيف، لأن نزول الآية على هذا السبب لم يصح، ولا هو مما يساعد عليه نظم الآية التي معها، وما قالوه في ذلك إنما هو تفسير وتأويل، وليس فيه شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب من العموم، ولكنهم تأولوه على أمر الندب، وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية، ولو قالوا المراد من قوله قرئ قراءة خاصة، وهي أن يقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس لعلم ما فيه، والعمل به للكافر والمسلم، لكان أحسن تأويلا.
وفي «تفسير القرطبي» عن سعيد (بن المسيب) : كان المشركون يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنزل الله تعالى جوابا لهم “وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا”.
على أن ما تقدم من الأخبار في محمل سبب نزول هذه الآية لا يستقيم، لأن الآية مكية، وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما استدلال أصحاب أبي حنيفة على ترك قراءة المأموم إذا كان الإمام مسرا بالقراءة، فالآية بمعزل عنه إذ لا يتحقق في ذلك الترك معنى الإنصات.
ويجب التنبه إلى أن ليس في الآية صيغة من صيغ العموم، لأن الذي فيها فعلان هما (قرئ) (واستمعوا) والفعل لا عموم له في الإثبات.
ومعنى الشرط المستفاد من (إذا) لا يقتضي إلا عموم الأحوال، أو الأزمان دون القراءات، وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستلزم عموم الأشخاص، بخلاف العكس كما هو بين».([18])
والاستماع لقراءة من يقرأ القرءان مختلف فيه، وكذلك في استماع المأموم لقراءة إمامه، هل واجب عليه الاستماع، ولا يشتغل بغيره، ولو قراءة الفاتحة؟، وهذه القضية تحدث عنها الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرءان، وفصل فيها القول، فقال: “وقد روى الناس في قراءة المأموم خلف الإمام بفاتحة الكتاب أحاديث كثيرة، أعظمهم في ذلك اهتبالاً الدارقطنيُّ.
وقد جمع البخاري في ذلك جزءا، وكان رأيه قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهي إحدى روايات مالك، وهو اختيار الشافعي.
وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة؛ إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله: اقرءوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل». وقد اختلفت في ذلك الآثار عن الصحابة والتابعين اختلافا متباينا، فروي عن زيد بن أسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام». وقد روي عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فقرأ قوم خلفه، فقال: ما لكم لا تعقلون؟ {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204].
وقد قال أبو هريرة: نزلت الآية في الصلاة. وقيل: كانوا يتكلمون في الصلاة، فنزلت الآية في النهي عن ذلك.
وروي أن فتى كان يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ فيه النبي، فأنزل الله الآية فيه.
وقال مجاهد: نزلت في خطبة الجمعة؛ وهو قول ضعيف؛ لأن القرآن فيها قليل، والإنصات واجب في جميعها.
وقد روي أن عبادة بن الصامت قرأ بها، وسئل عن ذلك، فقال: لا صلاة إلا بها. وأصح منه قول جابر: لا يقرأ بها خلف الإمام، خرجه مالك في الموطإ.
وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا»؛ وهذا نص لا مطعن فيه، يعضده القرآن والسنة، وقد غمزه الدارقطني بما لا يقدح فيه.
المسألة الثالثة: الأحاديث في ذلك كثيرة قد أشرنا إلى بعضها، وذكرنا نبذا منها، والترجيح أولى ما اتبع فيها. والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار.
وأما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: أحدها: أنه عمل أهل المدينة.
الثاني: أنه حكم القرآن قال الله سبحانه: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]. وقد عضدته السنة بحديثين: أحدهما: حديث عمران بن حصين: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها».
الثاني: قوله: ” وإذا قرأ فأنصتوا “.
الوجه الثالث: في الترجيح: إن القراءة مع جهر الإمام لا سبيل إليها فمتى يقرأ؟ فإن قيل: يقرأ في سكتة الإمام. قلنا: السكوت لا يلزم الإمام فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض، لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر، وهذا نظام القرآن والحديث، وحفظ العبادة، ومراعاة السنة، وعمل بالترجيح والله أعلم؛ وهو المراد بقوله تعالى: {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين}[الأعراف: 205] وهي: الآية السادسة والعشرون فقوله: {في نفسك} [الأعراف: 205] يعني صلاة الجهر. وقوله: {ودون الجهر من القول} [الأعراف: 205] يعني صلاة السر فإنه يسمع فيه نفسه ومن يليه قليلا بحركة اللسان.
فإن قيل: فقد قال بعض الشافعية: إنما خرجت الآية على سبب؛ وهو أن قوما كانوا يكثرون اللغط في قراءة رسول الله، ويمنعون من استماع الأحداث لهم، كما قال تعالى: {وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون} [فصلت: 26]، فأمر المسلمين بالإنصات حالة أداء الوحي، ليكون على خلاف حال الكفار.
قلنا: عنه جوابان: أحدهما: أن هذا لم يصح سنده؛ فلا ينفع معتمده.
الثاني: أن سبب الآية والحديث إذا كان خاصا لا يمنع من التعلق بظاهره إذا كان عاما مستقلا بنفسه، وبالجملة فليس للبخاري ولا للشافعية كلام ينفع بعدما رجحنا به واحتججنا بمنصوصه، وقد مهدنا القول في مسائل الخلاف تمهيدا يسكن كل جأش نافر» ([19].)
الفرع الثالث: حكم الاستماع لقراءة من يقرأ القرءان
هذه المسألة اختلف فيها العلماء بناء على اختلافهم في دلالة الأمر وسبب نزول الآية، وقد وردت عدة أسباب لنزول الآية، غير أنها لا تصل كلها إلى درجة الصحيح، كما أشار إلى ذلك العلماء، وقال بعضهم لو قلنا بوجوب الاستماع كلما سمعنا القرءان لكان الأمر فيه مشقة، ولهذا حمله الطاهر ابن عاشور على الندب، وهذا المسألة تتفرع عنها مسألة فقهية مختلف فيها، وهي هل المأموم مطلوب منه الاستماع لقراءة إمامه، أو أن يقرأ فاتحة الكتاب، فهناك من ألزمه بقراءة الفاتحة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية كالشافعية للحديث المعروف” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” ومن العلماء من لم يلزمه بها في كلتا الحالتين، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، ومنهم من فصل كالمالكية فقالوا إن كان في السرية فهو مطالب بقراءتها، وإن كان في الجهرية فالمطلوب منه الاستماع لقراءة الإمام كما رأينا في كلام ابن العربي.
المبحث الثالث: العمرة
قال الله تعالى:{ وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة:196]
الفرع الأول: معنى الإتمام والحج والعمرة
يقول الراغب الأصفهاني: «تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه والناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنه».([20])
معنى الحج، الحج: “القصد للزيارة. خص في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك».([21])
معنى العمرة، يقول الراغب: «والاعتمار والعمرة: الزيارة التي فيها عمارة الود، وجُعل في الشريعة للقصد المخصوص».([22])
ويقول صالح عبد السميع[23] معرفاً الحج شرعاً: ” عبادة مشتملة على إحرام وحضور بعرفة جزءاً من ليلة النحر وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة».([24])
وعرف العمرة بقوله: « العبادة المشتملة على إحرام وطواف وسعي».([25])
الفرع الثاني: دلالة الأمر في الآية الكريمة
اختلف العلماء في حكم العمرة بسبب دلالة الأمر [وأتموا]، وقد حكى ابن رشد الحفيد الخلاف في ذلك فقال: «فإن قوما قالوا: إنه واجب، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي، وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر، وجماعة من التابعين. وقال مالك وجماعة: هي سنة. وقال أبو حنيفة: هي تطوع، وبه قال أبو ثور وداود، فمن أوجبها احتج بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وبآثار مروية، منها: ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: «دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام يا رسول الله؟ فقال: أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة».([26])
وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه: «لما نزلت: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : باثنتين حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة».
وروي عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: “الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت”.([27]) وروي عن ابن عباس: ” العمرة واجبة “. ([28]) وبعضهم يرفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم. وأما حجة الفريق الثاني-وهم الذين يرون أنها ليست واجبة – فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر معها العمرة، مثل حديث ابن عمر: “بني الإسلام على خمس” ([29]) ذكر الحج مفردا. ومثل حديث السائل عن الإسلام، ([30]) فإن في بعض طرقه: “وأن يحج البيت”. وربما قالوا: إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب، لأن هذا يخص السنن والفرائض أعني: إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع.
واحتج هؤلاء أيضا – أعني: من قال إنها سنة – بآثار، منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، ولأن تعتمر خير لك”.([31])
قال أبو عمر بن عبد البر: وليس هو حجة فيما انفرد به، وربما احتج من قال: إنها تطوع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الحج واجب والعمرة تطوع”.([32]) وهو حديث منقطع.
فسبب الخلاف في هذا تعارض الآثار في هذا الباب، وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه». ([33])
وقد ذكر ابن العربي كلاماً يعلل فيه عدم الوجوب فقال: « وليس في هذه الآية حجة للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة، فقال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها، وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء».([34])
وقد أورد الإمام الشوكاني مجموعة من الأحاديث لكلا الفريقين الدالة على الوجوب غيره، وقد تقدم البعض منها، ثم قال: «والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحج في حديث: “بني الإسلام على خمس” واقتصار الله جل جلاله على الحج في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] وقد استُدل على الوجوب بحديث عمر ([35])الآتي قريبا وسيأتي الجواب عنه. وأما قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فلفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله».([36])
ومما أضافه ابن عاشور في هذه الآية من خلال كتابه التحرير والتنوير قوله: «وليس في الآية حجة عند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله على وجوب الحج ولا العمرة، ولكن دليل حكم الحج والعمرة عندهما غير هذه الآية، وعليه فمجمل الآية عندهما على وجوب هاتين العبادتين لمن أحرم لهما، فأما مالك فقد عدهما من العبادات التي تجب بالشروع فيها، وهي سبع عبادات عندنا هي الصلاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والطواف، والائتمام، وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلها بالشروع.
ومن لم ير وجوب النوافل بالشروع ولم ير العمرة واجبة يجعل حكم إتمامها كحكم أصل الشروع فيها، ويكون الأمر بالإتمام في الآية مستعملا في القدر المشترك من الطلب اعتمادا على القرائن، ومن هؤلاء من قرأ، (والعمرة) بالرفع حتى لا تكون فيما شمله الأمر بالإتمام بناء على أن الأمر للوجوب فيختص بالحج.
وجعلها الشافعية دليلا على وجوب العمرة كالحج، ووجه الاستدلال له أن الله أمر بإتمامها فإما أن يكون الأمر بالإتمام مرادا به الإتيان بهما تامين أي مستجمعي الشرائط والأركان، فالمراد بالإتمام المعنى الشرعي على أحد الاستعمالين السابقين، قالوا: إذ ليس هنا كلام على الشروع حتى يؤمر بالإتمام، ولأنه معضود بقراءة “وأقيموا الحج” وإما أن يكون المراد بالإتمام هنا الإتيان على آخر العبادة فهو يستلزم الأمر بالشروع، لأن الإتمام يتوقف على الشروع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون الأمر بالإتمام كناية عن الأمر بالفعل.
والحق أن حمل الأمر في ذلك بأصل الماهية لا بصفتها استعمال قليل كما عرفت، وقراءة: “وأقيموا” لشذوذها لا تكون داعيا للتأويل، ولا تتنزل منزلة خبر الآحاد، إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه، وأما على الاحتمال الأول فلأن التكني بالإتمام عن إيجاب الفعل مصير إلى خلال الظاهر، مع أن اللفظ صالح للحمل على الظاهر بأن يدل على معنى: إذا شرعتم فأتموا الحج والعمرة، فيكون من دلالة الاقتضاء، ويكون حقيقة وإيجازا بديعا، وهو الذي يؤذن به السياق كما قدمنا، لأنهم كانوا نووا العمرة، على أن شأن إيجاب الوسيلة بإيجاب المتوسل إليه أن يكون المنصوص على وجوبه هو المقصد، فكيف يدعي الشافعية أن أتموا هنا مراد منه إيجاب الشروع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما أشار له العصام. فالحق أن الآية ليست دليلا لحكم العمرة». ([37])
الفرع الثالث: حكم العمرة
من خلال ما أوردناه من كلام العلماء نرى أن حكم العمرة مختلف فيه بين الوجوب وعدمه، ولكل دليله وحجته كما رأينا.
والذي قال بعدم الوجوب من الصحابة عمر وابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنهما، ومن التابعين عطاء والحسن البصري، ومن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك، غير أنهما يقولان بالإتمام لمن شرع فيهما.
ومن قال بالوجوب من الصحابة جابر ابن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين عطاء والحسن البصري، ومن الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد، ولهذا يقول الإمام الشافعي[38] في كتابه الأم:” والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة، فإن الله عز وجل قرنها مع الحج فقال {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن إحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات، وفي الحج زيادة عمل على العمرة، فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر، ومع ذلك قول ابن عباس وغيره».([39])
الخاتمة
هذا مما وجدته من النماذج في الأمر المختلف في دلالته وترتب عليها اختلاف فقهي، وهناك نماذج أخرى قد ننشرها في مقالات أخرى، منها ما يتعلق بالأمر، ومنها ما يتعلق بالنهي في القرآن الكريم، وهذا الجهد لا أدعي أنني أحطت فيه بجميع النماذج، رغم أني لم آلُ بحثاً وجهداً في التنقيب والبحث في كتب العلماء التي اهتمت بالموضوع، والنماذج المختلف في دلالتها وجدتها في الأمر أكثر من النهي، فالخلاف في النهي بين التحريم والكراهة قليل، كما أني وجدت من بين أسباب الخلاف بين العلماء في دلالة الأمر والنهي هو الاختلاف في القرينةِ الصارفةِ الأمرَ المطلقَ من الوجوب إلى الندب، أو النهيَ من التحريم إلى الكراهة.
ونوعية المصادر التي اعتمدت عليها هي كتب أحكام القرآن والتفسير، وكتب الخلاف العالي، وغيرها، وقد جمعت ما تفرق هنا وهناك لأعد هذا البحث المتواضع، والذي أعتبره بمثابة بداية الطريق في هذا المجال، وما زال الباب مفتوحاً أمام الباحثين وطلبة العلم لبذل الجهد أكثر سواء في دلالة الأمر، أو في جانب آخر مثل اختصاص الأمر والنهي ببعض المكلفين دون بعص، أو ما له سبب خاص من حيث سبب النزول أو سبب الورود.
وأخيراً أقول: فما كان من توفيق وفائدة في البحث فمن الله، وما كان من تقصير فمني ومن الشيطان، فأسأل الله القبول والإخلاص.
المصادر والمراجع
– القرآن الكريم برواية ورش عن نافع
– أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله القاضي أبي بكر ابن العربي(توفي:543)تحقيق محمد عبدالقادر عطا [دار الكتب العلمية بيروت -سنة الطبع 2012)
– أحكام القرآن لأحمد بن علي الجصاص، توفي:370، دار إحياء الترات العربي/بيروت لبنان، سنة الطبع 1992م)
– أحكام الأحكام على تحفة الحكام للشيخ محمد بن يوسف الكافي على منظومة القاضي محمد بن عاصم (توفي:829ه) [دار الفكر، بيروت، سنة الطبع 2000م)
– الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي (توفي:631) [دار الفكر دمشق- سنة الطبع 1981م)
– الأم للإمام الشافعي (توفي:204) تحقيق رفعت فوزي عبدالمطلب [دار الوفاء للطبع والنشر والتوزيع، المنصورة مصر، 2001)
– الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي ت 1396ه(دار العلم للملايين بيروت- سنة الطبع 2002م)
– بداية المجتهد ونهاية المقتصد ل تحقيق حامد أحمد الطاهر [دار الفجر للثرات، القاهرة،- سنة الطبع 2014م)
– تذكرة الحفاظ للذهبي.ت748(دار الكتب العلمية-بيروت-1419)
– جواهر الإكليل شرح مختصر خليل صالح عبدالسميع الأزهري تحقيق الدكتور سيد زكريا سيد محمد [دار الصحوة، القاهرة سنة الطبع 2011])
– حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني(دار الفكر، بيروت- سنة الطبع 1994)
– التحرير والتنوير لا بن عاشور (توفي:1973)[الدر التونسية للنشر- سنة الطبع 1984)
– التبصرة لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي توفي 476، دار الفكر بدمشق/ سنة الطبع 1983)
– التفسير والمفسرون لمحمد السيد حسين الذهبي ت 1398 (الناشر مكتبة وهبة القاهرة- سنة الطبع 2000م)
– الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب لابن فرحون-ت799ه(دار الترات للطبع والنشر- القاهرة)
– فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني(توفي852)[دار المعرفة بيروت- سنة الطبع1379ه)
– القاموس المحيط لأبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروز آبادي [توفى سنة الطبع 817 هـ). تحقيق عبدالخالق السيد عبدالخالق [مكتبة الإيمان، المنصورة، سنة الطبع 2009]
– الفصول في الأصول للجصاص[توفي:370] الناشر وزارة الأوقاف الكوتية سنة الطبع 199)
– اللمع للشيرازي [توفي:476]تحقيق عبدالقادر الخطيب الحسني[دار الحديث الكتانية سنة الطبع 2013)
– المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية (توفي:546)تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد [دار الكتب العلمية،بيروت،2011)
– المغني لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة [توفي:620] الناشر مكتبة القاهر _ سنة الطبع 1968م)
– الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر (توفي:463ه) [دار الكتب العلمية بيروت- سنة الطبع 2002)
– المستصفى للإمام الغزالي(توفي:505ه) تحقيق محمد عبدالسلام عبدالشافي[دار الكتب العلمية بيروت _ سنة الطبع 1413ه)
– مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشيخ التلمساني(توفي:771ه) الناشر دار الأمان الرباط سنة الطبع2017)
– معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني(توفي:502ه) تحقيق إبراهيم شمس الدين [مطبعة دار الفكر، بيروت، سنة الطبع 2004)
– نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني(توفي:1255ه) تحقيق عصام الدين الضابطي [دار الحديث، القاهرة، سنة الطبع 2005م)
نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، ت 772،دار الكتب العلمية-بيروت- سنة الطبع 1999)
– القوانين الفقهية لابن جُزَي (توفي:741ه) [دار ابن الهيثم، القاهرة، سنة الطبع 2009م)
– سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني (توفي:1182ه)[دار البيان الحديثة، القاهرة، سنة الطبع 2005م
– سير أعلام النبلاء للإمام لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت748) دار الحديث القاهرة-سنة الطبع 2006م)
– طبقات الشافعية لابن قاضي، ت851 (عالم الكتب-بيروت-سنة الطبع:1407ه)
– طبقات الحفاظ للسيوطي-ت911-(دار الكتب العلمية-بيروت-سنة الطبع1403ه
البحر المحيط للزركشي، ج:2، ص:365[1]
[2] ) الشيخ، الإمام، القدوة، المجتهد، شيخ الإسلام، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي، الشيرازي، الشافعي، نزيل بغداد، قيل: لقبه جمال الدين. مولده: في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة. توفي: ليلة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة، سنة ست وسبعين وأربع مائة.(سير أعلام النبلاء، ج:18، ص:553)
[4] ) الإمام، العلامة، المفتي، المجتهد، علم العراق، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، الحنفي، صاحب التصانيف. تفقه بأبي الحسن الكرخي، وكان صاحب حديث ورحلة. وصنف وجمع وتخرج به الأصحاب ببغداد، وإليه المنتهى في معرفة المذهب. مات: في ذي الحجة سنة سبعين وثلاث مائة، وله خمس وستون سنة.(سير أعلام النبلاء،ج:16،ص:340)
الفصول في الأصول،ج:2، ص:135[5]
المستصفى للإمام الغزالي، ج:2، ص:88[7]
[8] ) الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب: أديب، من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. من كتبه (محاضرات الأدباء – ط) مجلدان، و (الذريعة إلى مكارم الشريعة – ط) و (الأخلاق) ويسمى (أخلاق الراغب) و (جامع التفاسير)ت502ه (الأعلام للزركلي،ج:2،/ص:255)
) معجم مفردات الألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، ص:252[9]
[11] ) سبقت ترجمته
) أحكام القرآن للجصاص، ج:5، ص:47[12]
) أحكام القرآن الكريم للإمام ابن العربي، ج2:ص:370[13]
لابن رشد الحفيد(ص:237) ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد[14]
) القاموس المحيط، ص لفيروز أبادي: 623 مادة س م ع[15]
) القاموس المحيط، لفيروز آبادي:151، مادة ن ص ت [16]
[17] ) محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس.مولده ووفاته ودراسته بها. عين (عام 1932) شيخا للإسلام مالكيا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة، من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) و (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) و (التحرير والتنوير).ت 1377 ه(الأعلام للزركلي، ج:6، ص:174)
) التحرير والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشور، ج:ص:240[18]
) أحكام القرآن للإمام ابن العربي،ج:2، ص:368[19]
) معجم ألفاظ كلمات القرآن للراغب الأصفهاني، ص:86 [20]
[21] ) معجم ألفاظ كلمات القرآن للراغب الأصفهاني، ص:121
[22] ) نفس المصدر السابق،ص:388
[23] ) العالم الفهامة، الحبر العلامة: صالح عبدالسميع الآبي الأزهري أحد أعلام القرن الرابع عشر الهجري، فقيه مدقق، وإمام محقق، له شروح جياد على عدد غير قليل من كتب السادة المالكية: 1 هداية المتعبد السالك شرح مختصر الأخضري في مذهب مالك.2 الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. توفي: 1335ه (تحقيق الدكتور سيد زكريا سيد محمد عل ى جواهر الإكليل شرح مختصر خليل )
) جواهر الإكليل، ج:1 ص:307[24]
بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ ابن رشد الحفيد، ص:352[33]
أحكام القرآن للإمام ابن العربي، ج:1، ص:169[34]
[35] (يقصد حديث جبريل المعروف غير أنه فيه إضافة[وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء) واما رده عليه فقد قال الإمام الشوكاني:” فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة، ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران لا سيما وقد عارضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدم الوجوب.)
) نيل الأوطار، ج:2 ، ص:649[36]
) التحرير والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشور، ج:2/ ص:220[37]
[38]) هو الإمام المعروف محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة، ولد 150ه وتوفي204ه، قال شمس الدين الذهبي مترجماً له: (محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي، ثم المطلبي، الشافعي”. (سير أعلام النبلاء، ج:10، ص:5)
) الأم للإمام الشافعي، ج:2، ص:”327[39]

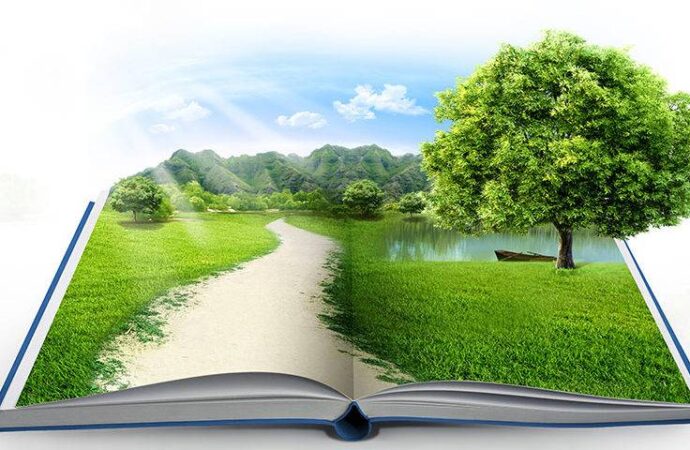
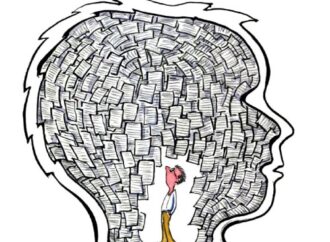

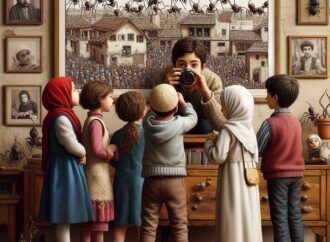
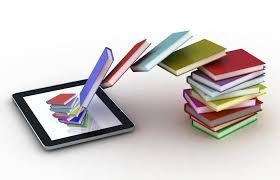
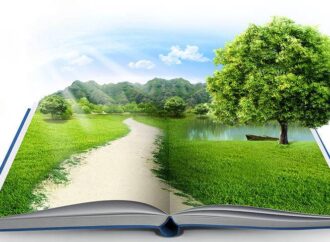






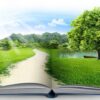

اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *